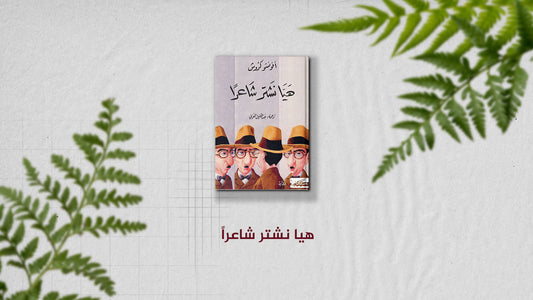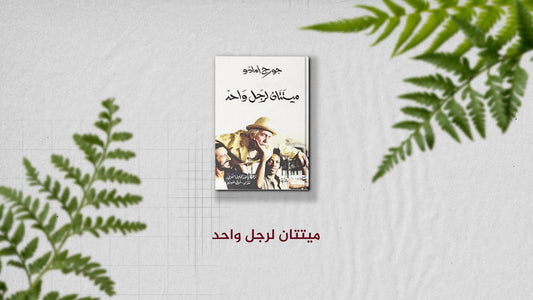مقدمة:إنّ ظاهرة الاستبداد من الظواهر المتجذرة في عمق ثقافتنا العربية الإسلامية، إذ عانت مجتمعاتنا، ومازالت تعاني، من ويلاتها منذ فجر العصر الأموي، وقد تصدى لهذه الظاهرة مناقشةً ونقداً عددٌ من الباحثين والمفكرين، منهم أحمد بن حمد الخليلي، المفتى العام لسلطنة عُمان، الذي وضع كتاباً عنوانه: "الاستبداد؛ مظاهره ومواجهته"، وقد صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عام 2013م، سنستعرض في الوريقات التالية استعراضاً موجزاً ومكثفاً أبرز ما ورد في هذا الكتاب من أفكار ومناقشات.
في مقدمة "الاستبداد":
تعرّضت حضارتنا العربية الإسلامية لتحول جذريّ في بدايات العصر الأموي؛ إذ انزاح الحكّام عن حالة العدل التي كانت سائدة خلال العصر الراشدي, لينتقلوا إلى حالة طافحة بالظلم والاستبداد،ومما يثير عجبنا ظهور العديد من الفتاوى التي تؤيد هذه الحالة الرجعية, غير المنسجمة مع الفطرة الإنسانية السليمة، والمنافية لروح الإسلام الحقّ، بل إنّ هذه الفتاوى مازالت حاضرة حتى يومنا هذا؛ إذ عادت إلى الظهور عند حدوث الربيع العربي، الذي ثارت فيه شعوبنا العربية على طغاتها ومستبديها.
وبالتالي، فإنّ النظر إلى حاضرنا، وما يكابده من هيمنة الاستبداد والمستبدين، لا يستقيم إلا باستقامة النظر إلى ماضينا، ووضع كلّ شيء نصابه، وإعطائه الحكم الشرعي، استهداءً بكتاب الله عزّ وجلّ، وأتباعاً لهدى نبيه المصطفى الكريم، وهذا ما تطمح إليه مناقشتنا الاستبداد في الحضارة العربية.
مظاهر الاستبداد:
لقد انتشر الظلم في الأمم، وقَبِلَ الناس به، ورضخوا له، وأذعنوا لحكم الجبابرة، المتحكمين بالأرواح والأجساد من غير وجه حقّ، فصاروا يرون الحسن قبيحاً والقبيح حسناً، والجور عدلاً والعدل جوراً، وذلك كلّه بسبب زيغ العقول، والانحراف عن الفطرة السليمة.
ونجد أنّ للسلطات الدينية والروحية دوراً كبيراً في ترسيخ الظلم في نفوس الناس، بل إنّ السلطات السياسية ما كانت لتصل إلى ما وصلت إليه لولا الاستعانة بهذه السلطات الدينية والروحية، وهذه الاستعانة لا نجدها في سياقنا المعاصر فحسب، بل نجدها، أيضاً، في العصور السحيقة.
إذ نراها عند الفراعنة، فلا يخفى على أحد منّا ما نُكبت به مصر وما حولها من بطش الفراعنة وظلمهم، وهم ما كانوا ليبلغوا ما بلغوه من استبداد لولا الدور التضليلي للكهنة، وسأروي لكم قصة قديمة عن تأثير الكهنة في نفوس الناس المتعرّضين لبطش الحكّام، فقد عاش في القرن العاشر قبل الميلاد طبيب فرعوني اسمه سنوحي، وسنوحي هذا ترك لنا مذكرات، كتب فيها فيما كتب أنّ رجلاً من عامة الشعب تعرّض لظلم هائل من الفرعون أمفيس، إذ سلبه ممتلكاته، وقهره، وبطش به، وعندما مات أمفيس كان هذا الرجل المظلوم يجهش بالبكاء, وهو يستمع إلى خطبة الكهنة، فظن سنوحي أنّ هذه الدموع هي دموع فرح لموت من ظلمه، ليكتشف,فيما بعد, أنّه يبكي حزناً على أمفيس، فقد كان لخطبة الكهنة دور تأثيري في تبديل مشاعره، وجعله متعاطفاً مع ظالمه.
كما نرى توظيف الديني في خدمة السياسي المستبد عند الروم،فعندما اعتنق هؤلاء الأباطرة الرومان الدين المسيحي اتحد بهم الباباوات، وروّضوا لهم الجامح، وذللوا لهم الصعاب، فكان الدين مرسّخاً لإخضاع الملايين لسطوة المستبدين.
وإذا ذهبنا إلى بلاد فارس سنرى أنّ الأكاسرة الفرس كانوا مقدسين لدى شعوبهم، فدماؤهم أطهر الدماء وأنقاها، وطباعهم مختلفة عن طباع البشر، فهم متسلسلون من عنصر موصول بالذات الإلهية، مما جعلهم مستبدين وظالمين للآخرين.
نسف الإسلام لهذه الأفكار الخاطئة والمناهج الظالمة:
جاء الإسلام فأتى على هذه الأفكار المظلمة كلّها فنسفها، جاعلاً الناس على قدم المساواة، لا يميز بعضهم من البعض الآخر سوى التقوى، بل إنّ الإسلام كان على القوي حتى يأخذ الحقّ منه، ومع الضعيف حتى يعيد حقّه إليه.
أما فيما يتعلق بالحكم، فالحكم لله وحده، ووظيفة الحاكم تنفيذ شرع الله، منصفاً بين الجميع، وكان النبي صل الله عليه وسلم أعلى مثل في إتباع ذلك وتطبيقه، فقاوم الجور حتى أقام دولة الحقّ، وأذاق الناس طعم الإنصاف، وحرر رقابهم من العبودية لغير الله تعالى, وعندما قبض الله تعالى النبي قامت الخلافة الراشدة، التي كان هديها امتداد لهدينبيه، فعمّرت الأرض بالعدل والإحسان.
وانطوت الخلافة الراشدة فانطوى معها العدل، وعادت الجاهلية لابسة لبوس الإسلام، فلم يبقَ من الخلافة سوى اسمها، وأصبح الحكم مطلقاً في يد شخص واحد، يأخذه عنوة لا شورى، وتساعده بطانته التي هي من جنسه، إذ تتزلف إليه، وتسفك الدماء من أجله، وتنشر بين الناس فكرة الطاعة المطلقة، بل كان الحاكم هو المالك المطلق للثروة، يسخّرها في شهواته من غير أن يحسب حساباً للشعوب التي تعاني من الحرمان، وتعيش عيشة الصعاليك.
وهذا العهد من الظلم والجور يشمل العصرين الأموي والعباسي، وإذا أردنا الاستثناء فيمكننا أن نستثني الخليفة عمر بن عبد العزيز، الذي أقام موازين القسط، وأعاد للأمة حقوقها المسلوبة.
انتقال الحكم من خلافة راشدة إلى سلطة استبدادية:
إنّ أعظم بلاء تعرّضت له أمتنا هو تحول نظام الحكم من نظام شورى، يقوم على العدل ومحاسبة النفس, إلى نظام شيطاني يقوم على الاستبداد، والجور، والبطش, بل يمكننا أن نعتبر هذا التحول حداً فاصلاً بين عهدين في حياة الأمة: عهد القوة والكرامة، وعهد الذل والضعف، فقد كان الحكّام في العهد الأول قضاة يحكمون بالعدل، وأمراء يباشرون إدارة البلاد، وكان الواحد منهم تقياً زاهداً، وأميراً حازماً، وبطلاً مجاهداً، وقاضياً فهماً، وفقيهاً مجتهداً، وسياسياً محنّكاً, أما الحكّام في العهد الثاني فهم ملوك مستبدون ظالمون, لا يرعون حرمات الله.
وقد بدأت الرحلة المشؤومة في تاريخ أمتنا في عهد معاوية، إذ ابتز الخلافة من الخليفة الشرعي، الذي بويع بإجماع أهل الحل والعقد، ليحولها إلى ملك عضوض، ونظام استبدادي، لا يصلح إلا أن يكون امتداداً للنظام المُتبع عند القياصرة والأكاسرة, ولم يكن معاوية يخفي أنّه أخذ السلطة عنوة، وأن الناس كارهة له.
وهناك نصوص صريحة تؤكد أنّ هذه الفئة التي انتزعت الحكم هي فئة باغية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صل الله عليه وسلم يبني المسجد، فإذا نقل الناس حجراً نقل عمار بن ياسر حجرين، وإذا نقلوا لبنة نقل لبنتين، فقال الرسول: "ويح ابن عمار تقتله الفئة الباغية".وقد قُتل ابن عمار على يد اتباع معاوية، مما يبين أنّهم المقصودون بقول "الفئة الباغية".
وهنالك العديد من أنصار الطغاة ممن حاولوا دحض هذا الحديث وطعنه، بل إنّنا نذهب إلى أنّ من رواة هذا الحديث معاوية نفسه، وبالتالي ما كان ليرويه لو لم يكن صحيحاً.
ولقد شن معاوية حرباً إعلامية على الخليفة الشرعي، فسن لعنَ علي بن أبي طالب على المنابر، وحمل الناس على شتمه بالترغيب والترهيب، وذلك لدحض الحقّ، وقلب الموازين في عقول الناس، ليروا المُحِّقّ مُبطلاً والمُبطل مُحقّاً، ولم تنقطع دابر البدع إلا في فترة خلافة عمر بن عبد العزيز.
استخلاف معاوية ليزيد:
كانت نية التوريث راسخة في نفس معاوية بن أبي سفيان، وإن وارها إلى أن حانت فرصة الإعلان عنها، وقد كانت هنالك معارضة لفكرة التوريث, غير أنّ معاوية لم يكترث لها، إذ أسكت المعارضين بحد السيف ليأخذ البيعة لابنه عنوة.
وممن تمرّد على معاوية ورفض إعطاء البيعة لابنه الحسين بن علي، إذ أعلن الثورة على الطاغية الجديد، واتجه صوب العراق التي دعته لنصرته ثم خذلته لاحقاً، فتمكّن منه جند الطاغية، وقتلوه، وكذلك نجد أنّ يزيد بن الزبير قد تمرّد, ورفض إعطاء البيعة ليزيد، واستقل بمكة وما دخل في حكمه من أقطار، زد على ذلك أنّ المدينة, بما فيها من المهاجرين والأنصار, قد ثارت على الطاغية بقيادة عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاري، فجرّد يزيد حملة ضده بقيادة مسلم بن عقبة، الذي عُرف باسم "مُسرف بن عقبة" لعظم جرائمه، فاستباح المدينة ثلاثة أيام, مرتكباً أفظع الجرائم وأشنعها.
وأخذ الله يزيد أخذ عزيز مقتدر, فتحول الحكم من آل أمية إلى آل أبي سفيان وآل مروان، وحكمُ بني مروان لم يكن أقل وطأة من حكم يزيد، بل ما كان أحدٌ أظلم من عبد الملك بن مروان، إذ كان أول من قطع ألسنة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد تحمّل عماله تبعة ترسيخ طاعته في النفوس وتقديمها على طاعة الله تعالى, وقامت العديد من الثورات في هذه المرحلة, إلا أنّها قد فشلت، ولعلّ أهم أسباب فشلها عدم اجتماعها تحت قيادة واحدة موحّدة.
ووُلّي, في هذه الفترة, عمر بن عبد العزيز الحكم وهو كارهٌ له، إذ كان قد ردّ أمر اختياره إلى المسلمين، فأطبقت كلمتهم على اختياره دون سواه, وقد أوقف عمر بن عبد العزيز بني أمية عند حدهم؛ ففطمهم عن شهواتهم، وأنزلهم المنزلة التي يستحقونها، وأحقّ الحقّ ونصره، ورفض الباطل وأزهقه.
مساندة فتاوى المارقين لجور الظالمين:
مما عزز جور بني أمي وظلمهم وقوف الفقهاء بفتاواهم إلى جانبهم، بل وصل بهم الأمر إلى أنّهم كانوا يبررون لهم الظلم ويشجعونهم عليه أيضاً، إذ ذهبوا إلى أنّ الخليفة لا حساب عليه ولا عذاب, وقدّموا طاعته على طاعة الله ورسوله, وحرّموا القيام عليه لدفع ظلمه وأخذ الحق منه,ونسبوا إلى رسول الله أنّه حرم الخروج عليه, فرووا أحاديث كاذبة موضوعة, بل كان هناك منهج ابتدعه الأمويون, ألا وهو رد الروايات, وإن صحت أسانيدها, عندما تتعارض مع سياساتهم، وقد عمدوا, أحياناً,إلى شطب بعض الروايات حتى لا يبقى لها أثر, واسترسل الفقهاء في تسويغ سياسة الإبادة لجماهير الأمة، فكان هنالك فتوى تتيح للحاكم أن يقتل ثلث الأمة من أجل إصلاحها, وقد وصلت الحال, لاحقاً, عند سلاطين آل عثمان إلى قتل السلطان لأخوته الذكور جميعاً عند وصوله إلى العرش، وذلك خشية المنافسة، بل كان الحاكم يقتل أخوته ولو كانوا رضعاً، وكان هذا يحدث على مرأى الفقهاء من دون أن يحركوا ساكناً.
ومن المعلوم أنّ الله حرم على عباده محارم، وأباح لهم ما أراد، ولم يجعل لأحد من عباده سلطة تشريعية تخوّله أن يحلل ويحرم من تلقاء نفسه، بيد أنّ الفقهاء أبوا إلا أن يتدخلوا في سياق التحريم والتحليل، فحللوا لأولي الأمر لبس الحرير والتختم بالذهب، وقد علل البوطي هذا السلوك بأنّ المسلمين فتحوا أعينهم على ما امتاز به حكّام العالم, فاتجهت الأنظار إلى الأخذ بذلك، إذ حرص هؤلاء الحكّام على أن ينقلوا إلى حياتهم ما عرفوه عن حياة الأكاسرة والأباطرة.
مواجهة الاستبداد:
لم تتردد أمتنا يوماً في الخروج على الحكّام الأمويين، لاسترداد الحقّ منهم وردهم إلى حكم الله، إلا أنّ أغلب الحركات التي قامت ضدهم باءت بالفشل، وسنتوقف فيما يلي عند ثورة الإمام عبد الله بن يحيى الكندي وقائده أبي حمزة المختار ابن عوف الشاري، تلك الثورة التي قامت بسبب نقض بني أمية لعهد الله، وخروجهم عن طاعته، وإهانتهم لعباده.
وقد أنشأ الإمام أبو الشعثاء جابر بن زيد مدرسة خاصّة، تُعنى بتكوين رجال يحملون مع الفقه، والدين، والبصيرة في العمل همومَ الأمة, وكانت هذه المدرسة عريقة, تستمد نهجها من كتاب الله وسنة نبيه، وقد حملت على عاتقها إحياء ما أُميت من الحقّ في هذه الأمة, وتكتم أبو الشعثاء على أمرة, وعلى الرّغم من هذا التكتم إلا أنّه لم يسلم من المضايقة.
وتوفي أبو الشعثاء فاستلم القيادة بعده أبو عبيدة، الذي تسلط عليه الحجاج، فألقاه هو وأخوه في السجن، ليأتي عليه الفرج بعد هلاك الحجاج, فيخرج من سجنه,ويستكمل تأسيس المدرسة.
وقد انتصرت ثورة هذه المدرسة في اليمن، وعندما فُتحت لهم أبواب البلاد ودخلوها لم يستحلوا لأنفسهم شيئاً، بل وزعوا ما وجدوه من مال على الفقراء، ليؤكدوا لأهل اليمن أنّ عهداً جديداً قد بدأ, ولم يكن هدف الثورة تحرير اليمن فحسب، بل كان هدفها تحرير الأمة، ولاسيما الحرمين الشريفين، وذلك لإعادتهما إلى قداستهما، فجرّد طالب الحق حملة إلى الحجاز بقيادة أبي حمزة الشاري، والذي وصفه قادة الدعوة في البصرة بأنّ"إنجيله في صدره"، وإن خرج أبو حمزة بجيشه إلى الحجاز فإنّه لم يكن يهدف إلى القتال، وإنما كان من باب أنّ الاستعداد للحرب يمنع الحرب.
وقد اختار أبو حمزة موسم الحج للدخول إلى مكة، فهذه فرصة كبيرة لعرض أفكاره، إذ اجتمع المسلمون من مختلف الأقاليم الإسلامية، وبعد استتباب الأمن في أرض الحرمين وجّه أبو حمزة عنايته إلى الطائف، وقد ظن أهلها، في البداية، أنّه جاء لسفك الدماء ونهب الأموال، كما اعتادوا من بني أمية، إلا أنّ جنود أبي حمزة كانوا مثالاً يُحتذى في التسامح.
وفي هذا الوقت خرج عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك ليحمس الناس على قتال أبي حمزة، وعندما علم أبو حمزة ذلك غادر مكة ليكون القتال خارجها، فيراعي حرمات الله، أضف إلى ذلك أنّ هذا الخروج أنجح في التخطيط العسكري، والتقى الفريقان في قديد، وحرص أبو حمزة على ألا تُسفك الدماء، كما حرص على الحرمات من أن تُنتهك، فأرسل إليهم بلح بن عقبة يدعوهم إلى الله ويذكرهم به، ويسألهم أن يكفوا أيديهم حتى يصلوا إلى مروان، فرفض قائدهم قائلاً: ليس بيننا وبينكم إلا الدم، فكان القتال وانتصر جند أبي حمزة، وذلك بسبب صلابتهم، وصمودهم، وحبهم للاستشهاد في المبادئ التي يعتنقونها.
وقد ظلّ أبو حمزة, بعد ذلك, يصدح بكلمة الحق على منبر رسول الله، فقال خطباً عدّة، شرح من خلالها مبادئه، وأسباب ثورته، وهذه الخطب سارت بها الركبان، وحفظها الرواة، وعُدّت من نماذج البلاغة العربية.
وما كان للطغاة في بلاد الشام أن يستكينوا لهذا الأمر الجلل الذي وقع في اليمن والحجاز، فأعدّ الطاغية مروان العدة، وأغرى جنوده بالمال والذهب، وعلى رأسهم عبد الملك بن عطية السعدي، وكان القتال، وهُزم جيش أبي حمزة، وعاد الفساد إلى الحرمين، ورجع بنو أمية إلى سيرتهم الأولى بالتشفي والانتقام.
أبو حمزة الشاري بين شهادات المنصفين وافتراءات الحاقدين:
من شأن الناس أن يتباينوا في المواقف, والآراء, والتوجهات، فهذه سنة الله عزّ وجلّ في خلقه، وقد اختلف الناس في مواقفهم من أبي حمزة الشاري, وسنذكر فيما يلي أبرز هذه الآراء والمواقف التي قيلت فيه.
فمن شهداء القسط بحقّ أبي حمزة: الشيخُ عبد المعز بن عبد الستار، والذي كتب بحثاً عنوانه: "تطبيق المبادئ الإسلامية في المواقف العسكرية"، وهو بحث مقدّم إلى ندوة الاحتفال بالإمام أبي حمزة الشاري, والداعية الشيخ إبراهيم زيد الكيلاني، الذي أعد بحثاً تضمن دراسة تحليلية بلاغية لخطب أبي حمزة, والشيخ عبد العزيز المجدوب، وهو من علماء جامعة الزيتونة، وكتب بحثاً عنوانه: "أبو حمزة الشاري؛ حركته، وأبعادها، وأسباب انحسارها", والشيخ محمد شحاته أبو الحسن من مصر، صاحب بحث: "أبو حمزة الشاري المختار بن عوف القائد الداعية"، وهو بحث ممتلئ بذكر مناقب أبي حمزة, كما ذكر الأستاذ كرامة مبارك أبا حمزة في كتابه: "الفكر والمجتمع في حضرموت", وهو كتاب مهمّ وبارز في موضوعه.
إلا أنّ الإنسان لا يسلم أيضاً من الذم والافتراء, فهنالك العديد ممن نسجوا الافتراءات الكاذبة والمُغرضة بحقّ أبي حمزة الشاري، ومنهم رجلٌ مجهول اسمه محشي الاسعاف، الذي علّق على كتاب: "اسعاف الأعيان في أنساب أهل عُمان", للشيخ سالم بن حمود السيابي، وقد أساء في تعليقاته، وشوهه بما أودع فيه من عبارات كاذبة، إذ ذهب إلى أنّ الشراة خرجوا على الدولة الإسلامية، وهاجموا الحرمين الشريفين.
شهادات بحق أبي حمزة الشاري:
شهادة من المغرب:
قال عبد العزيز المجدوب، في كتابه: "الصراع المذهبي بإفريقيا إلى قيام الدولة الزيدية": إنّ أبرز ما يتصف به الإباضيون تمسكهم الشديد بالدين، بأداء فروضه، وتجنب نواهيه إلى حد الغلو، وبغضهم المفرط لأصحاب الظلم والفساد، وبفضل هاتين الصفتين استطاعوا أن يحققوا لأنفسهم عزاً دينياً، ومجداً سياسياً، خلّد ذكرهم في التاريخ".
شهادة من المشرق:
قال حسين غباش في كتابه"عُمان الديمقراطية، تقاليد الإمامة والتاريخ السياسي الحديث":حركة فريدة، نشات وازدهرت على خلفية مذهب إسلامي أقلي، هو المذهب الإباضي، وانطبعت هذه الحقبة بالسعي إلى تشييد إمامة عادلة وفق النموذج الإباضي للدولة الإسلامية، وقد وجدت هذه الحركة الإباضية هويتها العقائدية والفكرية في زمن مبكر، ومن خلال محافظتها على مبدأ الشورى، والانتخاب الحرّ للأئمة، ومبدأ الإجماع والتعاقد يمكن أن تعد نفسها الوريث الحقيقي لتقاليد نظام الخلفاء الراشدين, ومن التقاليد المميزة لهذه المدرسة: الاعتدال، وعدم الثورة على الحكام إن كانوا عادلين، وإقرار مرحلة الكتمان.
وهناك, أيضاً, شهادة مهمّة لحسين مؤنس في كتابه:"دستور أمة الإسلام"، إذ ذهب إلى أنّ أمة الإسلام بعد انطواء عهد النبوة والخلافة فقدت الحكم الإسلامي النظيف إلا عند أصحاب هذه المدرسة.
نماذج حية وصور مثالية من الحرص على العدالة عند أبناء هذه المدرسة:
إنّ صفحات أبناء هذه المدرسة مليئة بنماذج العدالة والاستقامة, وسأتوقف عند بعض هذه النماذج, فعندما بغى أفراد من أسرة الإمام الجلندى بن مسعود لم يتردد في الإنصاف منهم، إذ مكّن المسلمين من رقابهم، فضُربت أمام الجمهور, وحدث أنّ استنجدت امرأة من القيروان, كانت قد تعرّضت لظلم قاسٍ من قبيلة, الإمامَ أبا الخطاب المعافري, فأنجدها، وخرج لنصرتها على رأس جيش، وحذر جيشه من أن يمد يده إلى شيء من ممتلكات خصمه، لأنّ أموالهم معصومة بتوحيد الله,أما الإمام الوارث بن كعب فقد جدّفي تطبيق العدل، فأمر بسجن مجموعة من الناس بموجب حكم شرعي في مكان قريب من الوادي، وحدث أن سال الوادي جارفاً، فخشي أن يغرق السجناء، فأمر بإطلاقهم، لكن لم يجرؤ السجانون على قطع الوادي، فسار إليهم بنفسه وأخرجهم,وممن حكم بالعدل, أيضاً, الإمام الصلت بن مالك، وفي زمانه غدر نصارى سوقطرى بواليه؛ فقتلوه، واستولوا على البلاد، وعاثوا فيها فساداً، فأنجده بأسطول، بإمرة رجلين يطمئن إلى عدلهما, في حين أنّ الإمام راشد بن سعيد اليحمدي, الذي أقام موازين القسط، لم يحاكم أحداًإلا بحكم من القاضي الشرعي حذراً من الخطأ, وهناك عمر بن الخطاب الخروصي, الذي كانت بلاد عُمان ترزخ قبله تحت نير الجور، إذ تسلط عليها الجبابرة، وأول إجراء اتخذه هو جهاد الجبابرة واسترداد الحقوق المسلوبة منهم, واذا انتقلنا إلى الإمام سالم بن راشد الخروصي, الذي خرّ صريعاً على الأرضعندما بويع بالإمامة,وذلك لهول الأمر الذي سيكلف به, سنجده غيوراً على حرمات الله، موزعاً وقته بين طلب العلم والقيام بالعبادات، وكذلك الإمام محمد بن عبد الله بن سعيد الخليلي الذي كان على قدر من الثراء، فسخّر ثروته كلّها في مصالح الأمة.
رفض الغلو في الفكر والسلوك:
تأبى هذه المدرسة تجاوز حدود الله، لذلك كان البون بينها وبين الغلاة شاثعاً، بل إنّ أصحاب هذه المدرسة نقضوا أفكار الغلاة، وفندوا شبهاتهم، وممن وقفوا في وجههم موقف الحازم,وأخذوا على أنفسهم نقض أباطيلهم، بل دفعوا شرهم بالسيف أحياناً، الخوارج, أولئك الغلاة الذين باينوا النهج السليم، فتشددت الأمة في محاسبتهم.
ونحن نذهب إلى أنّهم لم يغالوا إلا بسبب قسوة ما عانوه في ظل الحكم الأموي الجائر، فما مغالاتهم إلا ردة فعل عنيفة لما كانوا يلاقونه من العسف, والظلم, والجور.
دور علماء الإباضية في كشف طوايا الدعوة الوهابية:
إنّ الوهابية تملك نصوصاً طافحة بالتشريك, إذ يعدون من خالفهم من أهل الشرك, ولو أتي بأركان الإسلام الخمسة, وحافظ على شعائره, ويعتقدون, أيضاً, أنّ الناس كلّهم كانوا على الشرك قبل أن تظهر دعوتهم, وقد طبقت الوهابية أحكام أهل الشرك على الأمة, ففي قتالهم لهم استباحوا دماءهم، وكانت أموالهم غنائم تُوزع.
وقد شارك علماء الإباضية في نقض الدعوة الوهابية، وممن عاصر نشأة هذه الدعوة العلامة أبو نبهان، فألف رسائل وكتباً في تحذير الأمة من فتنتها,وممن ردّ, عليهم, أيضاً, العلامة منصور بن محمد بن ناصر بن خميس الخروصي، إذ رد على كتاب الشبهات الذي ألفه محمد بن عبد الوهاب.
خاتمة: قامت الثورات العربية فتضاربت الآراء حولها، إذ هنالك من شجع وأفتى بشرعية القيام على الظلمة، لكنه ظلّ متمسكاً بتأييد من سنوا الظلم في الأمة، وهناك من عارض هذه الثورات بشدة، فرفض المظاهرات، بل وصل به الأمر إلى أن طالب الحكّام بتحويل نظام الحكم إلى نظام وراثي، مثل فتوى محمود لطفي عامر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، وهذه الآراء ليست آراء معاصرة بل نجدها, أيضاً, في تاريخنا العربي السحيق, الذي انتشر فيه الظلم والاستبداد منذ مطلع فجر العصر الأموي, وفي النهاية, إنّ غايتنا من التعريج على هذا الموضوع هو بيان جانب مهمّ من جواب حضارتنا, كما هدفنا, أيضاً,إرضاء الله, ونصرة الحقّ, فما قيل ليس ناشئاً عن حقد, بل هو كلمة حقّ لا بدّ من أن تُقال.
كتابة: نور عباس