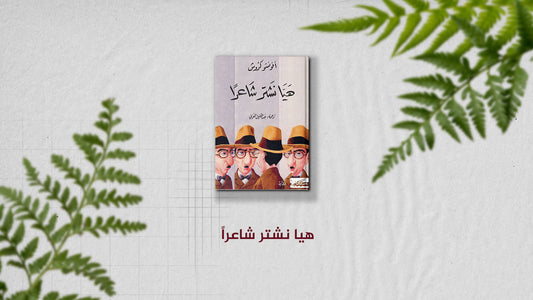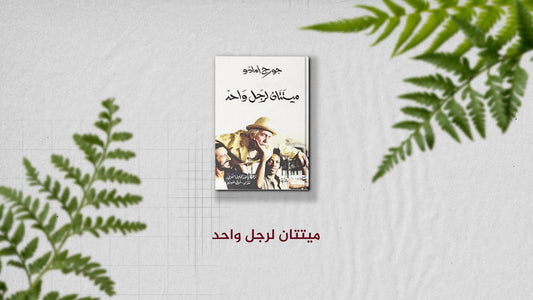مقدمة:يعيش عالمنا العربي، اليوم، صراعاً قيّمياً حقيقياً، وهذا الصراع قائم بين قيم العولمة من جهة والقيم الخاصّة بشعوب منطقتنا من جهة ثانية، بل يبدو أنّ هذا الصراع هو الصراع الأصلب والأقوى في تاريخنا.
ولأنّ القيم التي يتبناها الفرد هي المكوّن الأساس لشخصية المجتمع والأمة، ولأنّ خصوصيتنا القيمية الثقافية تتعرض لتغييب مقصود كان لا بدّ من التحرك السريع لدراسة موضوع القيم، ومن الكتب الموضوعة في هذا المجال كتاب: "أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقاتها في الحياة التعليمية"لإبراهيم رمضان ديب، وسنعمل، فيما يلي، على الوقوف عند هذا الكتاب، محاولين إيصال أبرز أفكاره، ووعي أهم مناقشاته.
ماهية القيمة وحقيقتها:
تأتي القيمة في اللغة بمعنى الشيء الغالي والنفيس، أما في مجال التربية فإنّ القيمة هي: مفهوم يتبناه الفرد، لاعتقاده بصحته عقلياً, ووجدانياً، ولربما إيمانياً، في حين أنّ القيمة في الشرع الحنيف هي: المعتقد، والاتجاه، والاهتمام، والطموح الذي يملأ على الفرد عقله وقلبه، فتمثّل المحرك الأساس لما يصدر عنه من أقوال وسلوكيات.
وهنالك، أيضاً، مفهوم آخر يتعالق مع مفهوم القيمة، ألا وهو النسق القيمي، ويُعرّف النسق القيمي بأنّه: مجموعة القيم التي يُراد إكسابها للطلاب عقلياً ووجدانياً خلال مرحلة معينة، وهذه المجموعة القيمية تُنسق وتُتناول وفق أهميتها وأولويتها بالنسبة للفرد والمجتمع.
مصادر القيم في المجتمعات العربية:
لكلّ أمة من الأمم مصادر خاصّة تستقي منها منظومتها القيمية، ومصادر القيم في ثقافتنا العربية تتمثل في: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وحياة الصحابة، والقياس والاستحسان، والأعراف والتقاليد الثقافية التي لا تخالف شرع الله تعالى.
وهذه المصادر القيمية تختلف اختلافاً جذرياً عن المصادر القيمية الغربية الأوروبية، إذ تلغي الثقافة الغربية الأوروبية الجانب الديني من مصادرها القيمية، بل إنّها تهمشه تهميشاً كلياً.
قوة القيم وفاعليتها:
للقيمة فاعلية كبيرة في نفوسنا، وتتحقق فاعليتهاالمُثلى من خلال: فهمنا الصحيح لها، وتدرّبنا على تنفيذها، وتفاعلنا معها نفسياً، وإحساسنا بالحاجة إليها، وقوة اعتزازنا بها.
السمات العشر لمنظومة القيم التربوية:
هنالك سمات مهمّة تتسم بها منظومتنا القيميّة العربية الإسلامية, وتمايزها من المنظومات القيمية الأخرى, ألا وهي:
الثبات:فهذه القيم لا تتغير بتغير الزمان والمكان.
التوثيق:أي أنّ القيم منقولة من مصادرة موثّقة, ولا سبيل إلى الشك فيها, مثل: القرآن الكريم والسنة الشريفة.
الشمول:إذ تشمل المنظومة القيمية جميع جوانب حياة الإنسان، بل إنّها تغطي, أيضاً, حياة الأمة كلّها.
التوازن:فالمنظومة متوازنة, دون إفراط أو تفريط.
مواكبة الفطرة الإنسانية:فالله سبحانه وتعالى حكيم, وخبير، وعليم بشؤون خلقه، وما يلزم لهم لضمان سعادة الفرد, والأسرة, والمجتمع، لذلك تجد هذه القيم تلبي احتياجات الإنسان وتشبعها في تناسق مستمر.
العملية:أي هي سهلة في الاستيعاب, والاكتساب, وكذلك هيّنةٌ في التطبيق، بل إنّها لا تكسب حيويتها إلا من خلال انتقالها من حيز الفهم النظري إلى حيز آخر, ألا وهو الحيز العمليالتطبيقي.
ارتباطها باليوم الآخر:إذ تنطلق مصادرها من الإيمان بالله واليوم الآخر، ما يمنحنا قوة دافعة للتمسك بها والعمل بموجبها.
ترتيبها:إنّ المنظومة القيمية ذات مصادر مرتبة في أولويتها، ويقع في أعلى هذا الهرم التراتبي القرآنُ الكريم.
تطويرية نهضوية: فكلّما تمسك بها الفرد أكثر كلّما ارتقى, وتطور, ونهض.
التطبيق التوظيفي لمنظومة القيم التربوية:
السؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن توظيف جوانب التميز في منظومتنا القيمية لخدمة العملية التعليمية والتربوية؟ ونحن نذهب إلى أنّه لا بدّ من إتباع الخطوات التالية لتحقيق توظيف نموذجي:
اطمئن في البداية إلى صحة هذه القيم، وإن كانت هذه القيم موضع الشك تأكّد من مصادرها، ووثقها توثيقاً تاريخياً، واجمع، بعد ذلك، أكبر قدر ممكن من الخبرات التراكمية التاريخية حولها، وتمازج معها, بل تمازج, أيضاً, مع زملائك العاملين في الحقل العلمي والتربوي، لتستفيد من تجاربهم السابقة.
وفي أثناء تعاملك مع الطالب تعامل معه تعاملاً شمولياً، فيتسع عملك ليشمل تربيته على القيم الاجتماعية والأخلاقية,بل عليك أن تهتم, أيضاً, بجانبه الإنساني والعاطفي, وانتبه إلى أمر مهمّ, ألا وهو التنسيق بين طبيعة المرحلة السنية والمنظومة القيمية التي تود تمريرها للطالب, زد على ذلك أنّه يتوجب عليك أن تجعل من نفسك نموذجاً عملياً للقيم التي تنادي بها, فأنت خير صورة مثالية يمكن أن يتأثر بها طالبك.
وخلال هذا كلّه يجب عليك استخدام الوسائل المساعدة, ولا بدّ لك في هذا السياق من أن توازن بين أدواتك دون إفراط أو تفريط، فكلّ نشاط له طبيعته وأدواته الخاصّة, واستخدم, أيضاً, الوسائل العملية بأكبر قدر ممكن, وكذلك تابع بدقة أثر القيم في الطالب، من خلال قياس المظاهر السلوكية لهذه القيم في واقعه اليومي.
المظاهر السلوكية السلبية الشائعة بين الطلاب:
هنالك مظاهر سلوكية سلبية حاضرة لدى طلابنا, وتتمثل بالآتي:
- الانشغال بالمظهر دون الجوهر.
- العشوائية في التعامل مع الوقت، والتفنن في إهداره.
- الانعزال عن قضايا المجتمع والأمة.
- تكبير الصغير وتصغير الكبير, وتقديم الزبد وتأخير الثمين.
- ضعف الانتماء للهوية الذاتية، والتشتت بين الهويات المختلفة, وقبول التبعية والرضا بها.
- الاكتفاء بوظيفة المستهلك للأفكار والمنتجات.
- العشوائية,وغياب الهدف, وافتقاد أسس اختيار الصديق.
مراحل بناء القيم في النفس:
يمكننا أن نرصد مراحل عدّة يؤدي اتباعنا لها إلى خطة لتجاوز القيم السلبية سابقة الذكر, وبناء قيم إيجابية في النفس الإنسانية, ألا وهي:
مرحلة التوعية:
لا بدّ من التوعية الشاملة للطالب بالقيم، وذلك من خلال إثارة انتباهه إليها، وجذب عواطفه وعقله نحوها، وتمريرها إلى وجدناه بالتتابع والتدرج المناسب لطبيعة شخصيته، وتحفيزه على التمسك بها,وتطبيقها في حياته.
بل إنّ التوعية تُبنى بإتباع الآتي:
إثارة انتباه الطالب نحو القيمة، أي جذب عقله وحواسه نحوها، وصرفه عن أي شواغل أخرى، وتتحقق الإثارة من خلال: السؤال, والقصة, واستخدام المشاهد المعبرة كالصور المتحركة, كما لا بدّ من تعريفه بالقيمة, وبيان أهميتها, ومجالات الاستفادة منها، ومن وسائل التعريف: الحوار, والمناقشة, والمشاهد التمثيلية, والمسابقات, زد على ذلك أنّه لابدّ من تحفيز الطالب على التمسك بهذه القيمة، من خلال بيان فضلها, وآثارها في الدنيا والآخرة، كما هنالك وسائل تحفيز مادية, مثل: الهدايا, والتكريمات, والتكنية.
وهنالك مؤشرات لنجاح مرحلة التوعية، تتمثل في: إظهار الطالب اهتمامه بالقيمة,ومحاولته معرفة كل تفاصيلها, أضف إلى ذلك إنصاته عند الحديث عنه, وتمسكه المبدئي ببعض جوانبها, وإظهاره بعض القلق عند عدم تنفيذه لها.
مرحلة الفهم:
تتعلق هذه المرحلة بالفهم الصحيح للقيمة, ذلك الفهم الخالي من الشبهات, والانحراف, والزلل,ما يمنح الطالب القدرة الجيدة على التفكير الصحيح, ويُبنى الفهم من خلال:تأصيل هذه القيمة في نفس الطالب من خلال الآيات والأحاديث, كما يمكن أن نأصلها له عقلياً من خلال الأدلة والبراهين, زد على ذلك أنّه لا بدّ من معايشة الطالب لنموذج يُقتدى به في هذه القيمة, بالإضافة إلى إخباره قصصاً واقعية عن تأثيرها الإيجابي في حياة الأشخاص.
ومن مؤشرات نجاح مرحلة الفهم:تكويّن الطالب تصورات واضحة عن هذه القيمة, ومسارعته إلى التمسك بها, وقلة انحرافاته عنها, وسرعة استجابته للتوجيه والتصويب.
مرحلة التطبيق:
وهي مرحلة التطبيق العملي, والممارسة الحقيقية للقيمة, وتتحقق هذه المرحلة باتباع الآتي:تفعيل أحداث مختلفة تخدم التدريب على القيمة, مع الالتزام بالتدرج والترقي, أضف إلى ذلك أنّه لا بدّ من متابعة الطالب, سواء أكانت المتابعة مباشرة أم غير المباشرة.
ولهذه المرحلة أدوات, منها: الأنشطة العملية للتدرب على القيمة, والمسابقات, والأبحاث, بل لمعرفة درجة نجاحنا ضمن هذه المرحلة لا بدّ من مؤشرات للنجاح, مثل: استجابة الطالب السريعة للتوجيه والتصحيح, وتفاعله مع الأنشطة, والتزامه بتطبيق القيمة في سلوكه.
مرحلة التعزيز:
والمقصود بها تعميق الفهم, وتجويد مستوى التطبيق العملي للقيمة, وتُحقق هذه المرحلة من خلال:المتابعة الجيدة للطالب, واتباع أسلوب الترغيب والترهيب لدفعه للالتزام بالقيمة, كما لا بدّ لنا في هذه المرحلة من منهجية التحفيز الإيجابي, وتقديم التكريمات للطالب الملتزم.
وهناك مؤشرات عدّة لنجاح هذه المرحلة, منها:ممارسة الطالب للقيمة ممارسة ذاتية, وإحساسه بالانتماء لها,الحرص على التعاون مع الآخرين، وتدريبهم على ممارستها.
النماذج العشر التطبيقية لمنظومة القيم المدرسية:
لا بدّ لنا من بناء منظومة تعليمية ذات بعد إنساني عالمي, قادرة على إحداث التماذج بين الأصالة والمعاصرة, ومهتمة بالتربية, ومركزة على تعزيز القيم الأخلاقية التالية:
قيمة تقدير الذات:
إنّ تقدير الذات هو مجموعة من المشاعر, والأحاسيس, والتفاعلات النفسية، التي تتكوّن لدى الطالب، فتؤكّد معرفته بذاته، وقدراته، ومواهبه، وأهميته، وجدارته بالاحترام وتقدير الآخرين، ما يمنحه الشعور بالرضا، والثقة، والاعتزاز بالنفس.
ولهذه القيمة مظاهر سلوكية, مثل: الثقة بالنفس, وسهولة الانخراط مع الطلاب الآخرين, والتطوع للقيام بالمهام, والتعامل بإيجابية مع المدح والثناء, والقدرة على التعبير عن النفس والمشاعر, ورفض الإهانة والتجريح.
بل لهذه القيمة أهمية في الحياة, إذ تمنح الطالب الشعور بالأمان, والثقة, والسعادة, وتدفعه إلى المشاركة بأكبر قدر من الأنشطة, كما تعزز طاقاته وإمكانياته, وتقوي تحصيله العلمي.
ولبناء هذه القيمة لا بدّ من مرورنا بالمراحل التالية: توعية الطالب وإثارة انتباه إلى أهمية تقديره لذاته, ومنحه فهماً صحيحاً وواضحاً لقيمة تقدير الذات, ومن ثم لا بدّ لنا من دفع الطالب إلى ممارسة هذه القيمة، ومتابعة مظاهره السلوكية بدقة, وتجويد تطبيقه العملي القيمي حتى يصل إلى التلقائية في الممارسة.
وللأسرة دور كبير في تعزيز قيمة الاعتزاز بالذات, بل إنّ هذا التعزيز يكون من خلال: احترام خصوصية الابن, وتخصيص غرفة له وأدوات مستقلة, وإظهار العناية والاهتمام به, والترحيب بأفكاره ومقترحاته, وتشجيعه على الانفتاح والتعرّف إلى الآخرين, وتجنب إهانته وجرح مشاعره.
قيمة التعاون:
إنّ التعاون هو الميل الوجداني والنفسي للتلميذ للتعاون مع زملائه، والعيش معهم بروح الفريق في كافة أنشطته اليومية, وتتمظهر هذه القيمة من خلال: حبّ التعرّف على الزملاء, وتكوين علاقات ناجحة مع الآخرين,وقبول الرأي الآخر والتعايش معه, والطموح, والهمة العالية, والاستعداد للمشاركة, ولهذه القيمة أهمية قصوى للطالب إذ تساعد الطالب في تنمية مهاراته, وتمنحه الثقة بالنفس, وتنمي استعداده للتلقي والتفاعل, كما تحفظه من الزلل والانحراف.
ولبناء هذه القيمة لا بدّ من أن نمرّ بالمراحل التالية:إثارة انتباه الطالب نحو أهمية التعاون, وتدريبه على ممارسته في حياته اليومية,ومراقبته حتى يصل إلى مرحلة الممارسة الذاتية التلقائية.
وللأسرة, أيضاً, دور بارز في تعزيز هذه القيمة, وذلك من خلال: تشجيع الابن وحثه على التعاون معهم في تنفيذ الواجبات المنزلية, وتنمية مهاراته التواصلية باصطحابه إلى مختلف المناسبات الاجتماعية, وقص قصص متنوعة, تكون تيمتها متمحورة حول التعاون.
إدارة الوقت واستثماره:
إدارة الوقت تعني الإحساس بأهمية الوقت, وحسن إدارته، واستغلاله استغلالاً جيداً، من خلال امتلاك مجموعة مهارات مرتبطة بالتخطيط وإدارة الوقت, وهناك مظاهر سلوكية تظهر عند من يخطط لوقته ويديره, وهي: التخطيط المسبق للأعمال, تحقيق قدر جيد من النجاحات, وتجنب مجالس اللهو وإهدار الوقت, والجدّية, والالتزام, والانضباط.
وتنعكس هذه القيمة في حياة الطالب, إذ يتمكّن من تنفيذ أكبر قدر من الواجبات في وقتها المحدد, كما يصل إلى النجاح والإبداع في الحياة, زد على ذلك أنّه ينمي مواهبه وقدراته, ويحفظ نفسه من الوقوع فريسة الفراغ والتشتت.
ولإيصال الطالب إلى هذه القيمة لا بدّ من المرور بمراحل, إذ علينا, أولاً, تنبيه الطالب إلى أهمية الوقت وقيمته, ومنحه, بعد ذلك لمحة عن الوقت, وخصائصه, وكيفية التفاعل معه, لننتقل إلى تدريبه العملي على إدارة وقته, ومتابعته حتى يصل إلى الاحترافية في تنفيذ هذه القيمة.
كما لا يمكننا إنكار دور الأسرة في تعميق إدارة الوقت في سلوكيات الابن, وذلك من خلال: اهتمام الوالدين بتعميم ثقافة التخطيط, والتعاون مع الابن في رسم ملامح مستقبله, وإشراكه في الدورات المتعلقة بالتخطيط.
قيمة بر الوالدين:
أي حب الوالدين، والاعتراف بفضلهما، والسعي إلى كسب رضاهما, ولبر الوالدين مظاهر عدّة, مثل: التلطف والتودد لهما, واحترامهما وتقديرهما, وخدمتهما وحسن عشرتهما,والاستماع لهما وطاعتهما, وعدم الإلحاح عليهما بالمطالب, ولبر الوالدين أهمية كبيرة, إذ تمنح البار رضا الله عز وجل,و رضا الوالدين.
ولبناء هذه القيمة لا بدّ من تحفيز الطالب على الاهتمام بوالديه وبرهما, وتعريفه بالوصايا الدينية المرتبطة ببر الوالدين, كما علينا توجيه لتنفيذ هذه القيمة, ومتابعته في أثناء التنفيذ, لنجوّد, بعد ذلك, مستوى تطبيقه, من خلال الثناء والتكريم المادي والمعنوي.
كما يتمثل دور الأسرة في تعميق هذه القيمة من خلال:عقد صداقة مع الابن, وتخصيص وقت كاف له, وتغذيته عاطفياً بالحب والحنان, وتأديبه بالآداب الأساسية, واصطحابه إلى المساجد ودور العلم,وبر الأجداد أمام أعينه, ليشكّل نموذجاً إيجابياً عن بر الوالدين.
قيمة الطموح:
إنّ الطموح هو الباعث النفسي والعقلي لبلوغ معالي الأمور، واستصغار ما دون ذلك، وهو مرتبط بالسعي, والعمل الحقيقي الدؤوب, وللطموح مظاهر كثيرة, مثل: الجد والاجتهاد, ومغالبة الصعاب, والحماسة, والإيجابية.
وللطموح أهمية عظيمة, إذ يحقق الطالب من خلاله الاستثمار الأمثل لموارده, ويوصله إلى التفوق, كما يشغله عن المعاصي والآثام, ويجعله يتحلى بمكارم الأخلاق.
ولتحقيق هذه القيمة يجب أن نوجه اهتمام الطالب نحو القضايا العظيمة والمهمّة, ونُفهمه مكونات الطموح وآليات تحقيقه, وندفعه لأن يكون إنساناً طموحاً, ونشجعه باستمرار حتى يتمكن من التغلب على المثبطات كلّها.
قيمة الحوار:
إنّ الحوار من أهم الأساليب الحكيمة في التواصل، ويهدف إلى إفصاح كلّ طرف عما لديه من أفكار وآراء لمناقشتها والوصول إلى الحقيقة عن اقتناع عقلي, ويتمظهر الحوار من خلال: حسن الاستماع والإنصات, وتحرّي الصدق والموضوعية, وتجنب اتهام أو تجريح الطرف الآخر, وحُسن البيان, وعدم الاستئثار بالحديث.
وللحوار أهمية عُظمى, إذ يمكّن الطالب من التواصل مع الآخرين واكتساب حبهم, ويمنحه القدرة على التأثير والإقناع, ويساعده في تنمية معارفه وزيادة خبراته.
ولبناء هذه القيمة علينا إثارة انتباه الطالب نحو أهمية الحوار ودوره في الحياة, بالإضافة إلى تعريفه بأنواع الحوارات, وخصائصها, وأهدافها, زد على ذلك أنّه لا بدّ من اعتماد مبدأ الحوار في التعامل مع الطالب، وحثه على التحاور مع الآخرين, إضافة إلى الثناء عليه وتكريمه عند الالتزام بالحوار وآدابه.
قيمة التفوق:
إنّ التفوق هو تعدي المتاح إلى ما بعده، بمعنى أن يتفوق الطالب على كلّ المتخصصين في المجال ويتعداهم، وأن يوظف هذا التفوق في خدمة المجتمع, وللتفوق مظاهر كثيرة, مثل: وضوح الأهداف في الذهن, والميل إلى حياة الجد والاجتهاد, والدقة, والنظام, والترتيب.
وتتمثل أهمية هذه القيمة في تنمية الثقة والإحساس بالذات, والاستقرار النفسي والعلمي, والقدرة على استكمال مسيرة التفوق, وكسب الحب والمكانة الاجتماعية بين الزملاء.
ولبناء هذه القيمة لا بدّ من خطوات, وهي: استنفار همة الطالب, والنقاش معه حول أهمية التفوق وحاجاتنا إليه, والتعاون معه في اختيار التخصص المناسب له, وتوجيهه المستمر للوصول إلى الهدف المنشود.
كما للأسرة دور في خلق شخص متفوق, من خلال: توفير البيئة الهادئة المساعدة في تحقيق الأهداف, وتأمين الوسائل والأدوات التعليمية اللازمة, ومنح مساحة من الترفيه والترويح عن النفس, والدعم المطلق والمستمر.
قيمة الحياء والعفة:
إنّ الحياء حالة نفسية, ووجدانية, وعقلية، وأصل كبير من أصول الاختلاف، يبعث على بلوغ معالي الفضائل، وترك القبائح, وللحياء مظاهر عدّة, منها:الاستشعار الدائم بمراقبة الله عز وجل, والرحمة, ولين الجانب, والاحتشام والوقار, وحسن الخلق وحلاوة العشرة, وعدم التجرؤ على الخطأ, كما للحياء أهمية كبيرة, إذ يحفظ الإنسان ويقيه من الوقوع في الخطأ والتشتت,ويبعده عن العديد من المشاكل اليومية.
وتتمثل مراحل بناء الحياء في:منح الطالب معارف حول هذه القيمة, وتعريفه الدقيق بعناصر الحياء, وسلوكياته, وأهدافه, إضافة إلى متابعته في أثناء التطبيقات, ولفت انتباهه إلى قدوة مثلى في هذا المجال.
وللأسرة الدور الأبرز في تعميق هذه القيمة, وذلك من خلال: الاهتمام منذ الصغر بتعليم الابن الآداب الإسلامية, واعتماد مبدأ الحوار والمناقشة معه, وربطه بنماذج حقيقية يقتدي بها.
قيمة الصداقة والأخوة:
الصداقة رباط وجداني ونفسي، وثقة واحترام متبادل بين اثنين، وولد ونشأ التقارب نتيجة تجانس اعتقادي, وثقافي, وسلوكي, وتظهر الصداقة من خلال: تفقد الغائب, وزيارة المريض, والتهادي, الإيثار, والاهتمام بالزملاء والسؤال عنهم.
وتتمثل أهمية هذه القيمة في: قدرتها على إشباع الحاجات النفسية والعاطفية, ودعم التفوق الدراسي من خلال التنافس الإيجابي, وإكساب المهارات الحياتية والخبرات الشخصية, وتدعيم روح الجماعة التي هي أساس الحياة الإنسانية الناجحة, ولبناء هذه القيمة يجب تعريف الطالب بها وتأصيلها في نفسه, ودفعه إلى تكوين صداقات مناسبة, والمتابعة الدقيقة لسلوكياته وتقويمها.
أما دور الأسرة في تعزيز هذه القيمة فيتمثل في:تشجيع الابن على تكوين صداقات, وإرشاده إلى معايير اختيار الصديق, وتوفير البيئة الصالحة لوجود أصدقاء جيدين, وفتح نقاشات حول الصداقة والأصدقاء.
قيمة الإيجابية:
إنّ الإيجابية هي الحركة العملية الذاتية, الناتجة عن حياة القلب, ويقظته, والإحساس بالمسؤولية والأمانة, مع توفر قدر من الهمة والقدرة على العمل والإنجاز, ومظاهر هذه القيمة هي: اليقظة والانتباه المستمر, والحيوية والنشاط, والمشاركة في الأنشطة المتنوعة, وقوة العزيمة وعلو الهمة, وحب العطاء, والبذل, والتضحية.
أما أهميتها فقائمة على: تنمية القدرة على الإنجاز والنجاح, وزيادة الخبرات والمهارات, وتدعيم الثقة بالنفس وتقدير الذات.
ولبناء هذه القيمة لا بدّ من استنفار فكر الطالب وطاقاته نحو الإيجابية، واستعراض حياة العديد من الأشخاص الذين أثروا بالحياة من خلال إيجابيتهم, كما لا بدّ من التعريف بالإيجابية, وبيان آليات تحقيقها, والتدريب العملي على مظاهرها السلوكية, وذلك من خلال دعوة الطلاب إلى الاشتراك بالأنشطة الخدمية العامة.
أما دور الأسرة في تعميق الإيجابية فيتمظهر في: تشجيع الابن على المشاركة في صنع القرار, وتنمية إحساسه بالمسؤولية, وتربيته على البذل والعطاء, وإشغاله بأعمال مفيدة.
خاتمة:ومن هنا، تلعب القيم دوراً أساسياً في توجيه ميول المجتمع وطاقاته، فهي المصدر الضابط للأفكار، والمشاعر، والطاقات، فعندما تأصلت منظومة القيم الإسلامية في المجتمع الإسلامي تمكّن من صناعة حضارة قوية وأمة عظيمة، فرضت نفسها على الأمم الأخرى؛ إذ ارتقت منظومة القيم الإسلامية بالمجتمع البدوي, وسمت بأفكاره, وميوله, ومجتمعاته, لذلك رهاننا اليوم هو رهان على قيمنا وقدرتنا على إعادة توجيهها للارتقاء مجدداً بأمتنا الإسلامية.
كتابة: نور عباس