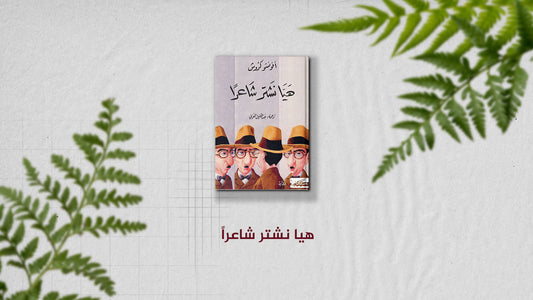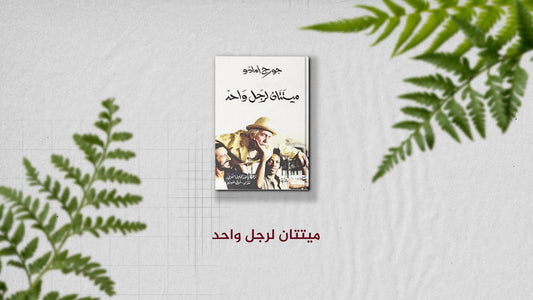مقدمة: إنّ موضوع مبادئ الإدارة وأسسها وأصولها العلمية من أكثر المواضيع التي شهدت تغييراً في ممارساتها التطبيقية ومفاهيمها الفلسفية على حد سواء، وذلك بسبب حالة التسارع والتجدد والتطور والتي هي السمة الأساسية للأنشطة الإدارية بأنواعها كلّها، لذا كان لزاماً علينا أن نهتم بهذا الموضوع، ونطالع أبرز الكتب المتمحورة حوله، ومن الكتب المهتمة بهذا المجال كتاب: "مبادئ الإدارة؛ الأصول والأساليب العلمية"لمؤلفيه: علي فلاح وعبد الوهاب بن بريكة، والذي سنتوقف عند أبرز تمفصلاته في وريقاتنا الآتية.
مفهوم الإدارة وتعريفها:
ليس هنالك تصور محدد لماهية النشاط الإداري، وحدوده، ومضمونه، ويعرّف تايلور الإدارة بأنّها: المعرفة الصحيحة لما تريد من الرجال أن يقوموا بعمله، ثم رؤيتك إياهم يعملونه بأحسن طريقة وأرخصها، أما بيتر دركر فيعرّف الإدارة بأنّها: عضو له وظائف متعددة، وهي التي تدير العمال والعمل، كما عُرفت الإدارة بالتالي: فن التخطيط لنشاط يتعلق بحسن استعمال الموارد البشرية والمالية لتحقيق أهداف المؤسسة، في حين يعرّفها هنري فايول بقوله: معنى أن تدير هو أن تتنبأ، وتخطط، وتنظّم، وتصدر الأوامر، وتنسق، وتراقب، والإدارة، أيضاً، هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يصف، ويفسر، ويحلل، ويتنبأ بالظواهر الإدارية، ومن كلّ ما سبق يمكننا القول: إنّ الإدارة عملية اجتماعية مستمرة، بقصد استغلال الموارد الاستغلال الأمثل، عن طريق التخطيط، والتوجيه، والرقابة, للوصول إلى الهدف بكفاية وفاعلية.
وتكمن أهمية الإدارة في أنّها أداة لتقدم الأمم، فهي المسؤلة عن نجاح المنظمات داخل المجتمع، والنظم الاقتصادية، والمشروعات المختلفة للدول والجماعات والأفراد، بل إنّ هنالك دولاً تمتلك موارد هائلة لكنها تضيعها بسبب سوء الإدارة.
الإدارة بين العلم والفن:
هنالك جدل كبير، فمنهم من يذهب إلى أنّ الإدارة علم، يعتمد عل مبادئ وقوانين محددة، وبعضهم يذهب إلى أنّها فن، يقوم على الخبرات الشخصية، والمهارات الخاصة، والذكاء الاجتماعي، ونحن نذهب إلى أنّ الإدارة علم وفن، فهي لا تخلو من القواعد الناظمة، إلا أنّ نجاح الإداري يعتمد، أيضاً، على حسه، وذكائه، وفنيته في التعامل مع المشاكل الإدارية.
علاقة الإدارة بفروع العلوم الأخرى:
للإدارة علائق وطيدة مع مختلف العلوم الأخرى، إذ لا بدّ للإداري من أن يكون ملماً بعلم الاقتصاد، بل إنّ هدف علم الاقتصاد هو استغلال الموارد المادية والبشرية بأقصى درجة ممكنة لإشباع الحاجات الإنسانية، وهذا الهدف يتعالق مع هدف الإدارة، التي تعمل على وضع الخطط لاستغلال كافة الموارد المتاحة، أما علم الاجتماع فهو يهتم بنشأة المجتمعات، وتطورها، وتحول العلاقات فيها، وبالتالي لا بدّ للإدراي من الاهتمام بعلم الاجتماع، إذ تُعتبر المؤسسة مجتمعاً صغيراً، يساعد علم الاجتماع في دراستها وإدارة التعامل مع المجموعات الموجودة فيها, في حين أنّ علم النفس يهتم بسلوك الفرد والعوامل التي تؤثر فيه، وهذا العلم ضروري للإداري، إذ من خلاله يستطيع معرفة آليات التعامل مع مختلف الشخصيات, أما العلوم الرياضية فهي مهمّة جداً للإداري، إذ يساعده الإحصاء ونظريات الاحتمال في الوصول إلى قرارات رشيدة.
مراحل تطور الفكر الإداري:
عملية الإدارة قديمة، إذ ارتبطت بالحضارات الإنسانية السحيقة، مثل الحضارة السومرية التي أوجدت أنظمة القياس والبريد، والحضارة البابلية التي أوجدت نظام الأجور والعقود، والحضارة المصرية التي شيدت الأهرامات دليلاً على الحس الإداري والتنظيمي، أضف إلى ذلك أن الفراعنة اعتمدوا على التخطيط لتقدير محاصيل الغلال سنوياً، كما استخدموا الإحصاء لمعرفة عدد السكان، وراعوا الكفاءة الإدارية في اختيار الموظفين، كما كتبوا التقارير، وامتلكوا السجلات، واعتمدوا نظاماً للأجور.فالإدارة ظاهرة ترافق المجتمعات سواء أكانت مجتمعات معاصرة أم قديمة.
الإدارة في الإسلام:
تتسم الإدارة الإسلامية بأنّها مرتبطة بأخلاقيات الدين الإسلامي، كما أنّها تركز على الحافز المادي، وتهتم بالشورى، أضف إلى ذلك أنها تقوم على توزيع المهام والمسؤوليات, ولقد ترك الإسلام تراثاً خالداً على صعيد الإدارة، فهناك تنظيم الوزارات والدواوين، مثل ديوان الجند، وديوان بيت المال، وهناك أيضاً تقسيم الإدارة إلى إدارة مركزية وإدارة لا مركزية، زد على ذلك تحديد الميزانية.
وإذا أردنا أن نصف الإدارة الإسلامية يمكننا أن نقول: إنّها إدارة تسير وفق أصول الشريعة، ووفق أخلاقيات محددة، وترتكز على عناصر بشرية فاعلة، وتؤكد على ضرورة تحقيق المصلحة العامة.
بل من أبرز مصادر هذه الإدارة القرآن الكريم، والسنة النبوية، وهما المصدران الأساسيان للإدارة الإسلامية، أما المصدران الفرعيان فهما الإجماع والقياس.
طبيعة الإدارة:
تتمظهر طبيعة الإدارة من خلال ثلاثة عناصر؛ الاستمرارية: بمعنى أنّها موضوع مستمر باستمرار الوجود الإنساني. والتنسيق: أي لا بدّ من وجود تفاعل بين العناصر المُدارة للوصول إلى الأهداف المحددة. واتخاذ القرار: أي العزم على أمر ما، ووضعه موضع التنفيذ، وذلك بعد تحليل الموقف، واختيار السبيل المناسب، في ضوء المعلومات والبيانات المتاحة.
أبعاد الإدارة:
وللإدارة أبعاد:بعد اقتصادي، وهذا البعد يعتمد على جانبين: الفعالية؛ أي تحقيق أفضل النتائج. والكفاءة؛ بمعنى الاستخدام الأمثل للعناصر. وبعد إنساني، والذي يعتمد، أيضاً، على جانبين: تحقيق ذات الإنسان العامل، وإحداث التنسيق، والتعاون، والتكامل بين الأفراد.وبعد زمني، والذي يقوم على إحداث التوازن بين: الواقع الفعلي أي الحاضر، والواقع المستهدف تحقيقه أي المستقبل.
أساليب الإدارة:
تتنوع أساليب الإدارة، ويمكننا أن نحصرها بالتالي؛ إدارة "اللوائح أولاً": وشعارها الدائم "النظم واللوائح أولاً" حتى وإن كانت هذه اللوائح تضر بالعمل والعاملين، ومن ثم لا تسأل عن احتمالية وجود إبداع ومبدعين.إدارة بلا إدارة: وشعارها الدائم "دعه يعمل دعه يمر"، فهي دائماً بانتظار الآخرين، إذ تعتمد على ردة الفعل أكثر من الفعل.إدارة الأفراد: وشعارها الدائم "كلّ شيء يسير بتوجيه المدير"، فالمدير هو المسؤول عن كلّ شيء.إدارة تسيير الأعمال: وشعارها الدائم "القناعة كنز لا يفنى"، فهي لا هم لها سوى أن يسير العمل بطريقة روتينية.إدارة التفاؤل غير المبرر: وشعارها الدائم "كلّ شيء على ما يرام" حتى وإن كان الواقع غير ذلك.إدارة المشاركة: وهي التي تحمل شعار "كلّنا في سفينة واحدة"، فهي تقوم على المشاركة في تحمل المسؤولية.
مبادئ الإدارة:
لكي تحقق الإدارة أهدافها لا بدّ من أن تتبع المبادئ التالية:مبدأ الموضوعية: أي فهم مجمل اللوائح الداخلية والعمل على الاستفادة منها.ومبدأ المستقبلية: أي على الإداري دراسة السياق العمومي والتنبؤ بالمستقبل.مبدأ الفاعلية: أي اعتماد الإسلوب الأمثل في التطبيق العملي للوصول إلى نتائج فاعلة.مبدأ الأولوية:أي اختيار العمليات التي ستنفذها في بداية المشروع تبعاً لأهميتها.مبدأ التكامل:أي التناغم والتكامل بين عناصر العمل ومكوناته.مبدأ الإنتاجية:أي تحقيق قيمة مضافة، بحيث تكون قيمة الناتج أعلى من قيمة المدخلات.
مدارس الفكر الإداري الكلاسيكي:
يشتمل الفكر الإداري الكلاسيكي على مدارس عدّة، فهناك مدرسة الإدارة العلمية، وتهتم هذه المدرسة، بالتحديد، بزيادة الإنتاح، وتخفيض ساعات العمل، والتركيز على فترات الراحة، أضف إلى ذلك أنّها تعتمد نظام الأجر التفاضلي، وهناك، أيضاً، المدرسة البيروقراطية، التي تمتاز بالرسمية في الإجراءات والتعاملات، كما أنّها تعتمد السلطلة الهرمية، والفصل بين ملكية الشركة وإدارتها، زد على ذلك أنها تؤكد على الرقابة والانضباط الدقيقين في أداء مهمات العاملين، أما مدرسة التقسيمات الإدارية فتؤكد على ضرورة وجود ضوابط واضحة للوظائف تجنباً لارتباك العمال.
مدارس الفكر الإنساني السلوكي:
إذا كانت المدارس الكلاسيكية قد ركزت على العمل والإنتاجية، فإن مدارس الفكر الإنساني السلوكي قد ركزت على العامل، ومن أبرز هذه المدارس مدرسة العلاقات الإنسانية، والتي تذهب إلى أنّ رفع الإنتاجية يتحقق من خلال اهتمام المدراء بالعاملين، فإذا لم يحدث هذا الاهتمام سيكره العامل عمله،وستقل الإنتاجية، لذلك لا بدّ من مراعاة حاجات العامل المختلفة، مثل الحاجة الفسيولوجية، وحاجة الأمان، وحاجة الحبّ، وحاجة تحقيق الذات وإثباتها.
مدارس الفكر الإداري الحديث والمعاصر:
هي المدارس التي تهتم بجوانب القيادة والإبداع، وتؤكد على المفاهيم الإدارية المعاصرة، ومن هذه المدارس المدرسة اليابانية والمدرسة الواقعية.
صفات المدير الناجح:
لا بد من أن تكون للمدير صفات جسمانية مثل الصحة والقوة، أضف إلى ذلك تمتعه بصفات عقلية مثل سرعة الفهم والاستيعاب والقدرة على حل المشكات، زد على ذلك الخبرة, وإلمامه بمختلف المعلومات عن الشركة، ولا يمكن, أيضاً, أن ننكر دور أخلاقيته في التعامل وسلوكياته العامة. كما لا بدّ من أن يمتلك مهارات فكرية مثل القدرة على التخطيط والتنظيم، وتحليل البيئة, واستخراج التحديات والفرص.ومهارات فنية: تتعلق بوضع الأهداف بطريقة فنية، ووضع معايير التقييم، وتصميم النظم، وإجراء المتابعة.إضافة إلى المهارات الإدارية القائمة على إدارة الاجتماعات، والتفاوض، وكتابة التقارير.
التخطيط الإداري:
إنّ التخطيط هو مجموعة المهام الإدارية التي تهدف إلى تحديد الأهداف المستقبلية للمنظمات والمؤسسات، وطرق تحديد هذه الأهداف.والتخطيط, أيضاً, هو التقرير سلفاً ما يجب عمله من أجل تحقيق هدف معين.وهو كذلك الاستثمار الأمثل والتوجيه السليم للموارد البشرية والمادية، لتحقيق الأهداف المرسومة، سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية، وذلك من خلال استخدام الوسائل والأساليب العلمية لضمان تحقيق هذا الأهداف ونجاح الخطة.والتخطيط لا يقتصر على مستوى الدولة فحسب، فالفرد يخطط، والجماعة تخطط, وكذلك المنظمة والمؤسسة.
لماذا نخطط؟
وهناك عدة أسباب تجعل من التخطيط أمراً حتمياً, فالشخص الذي وضع هدفاً له في الحياة، لا بدّ من أن يصل إلى هدف، وللوصول إلى هذا الهدف لا بدّ من خطة محكمة، تركز جهوده وتنظمها, كما لكلّ منا أدوار مختلفة في حياته، تعوقه عن تحقيق أهدافه، لذلك لا بدّ من خطة، تنظم هذه الأدوار وتدفعنا نحو الهدف, أضف إلى ذلك أنّ الإنسان يمتلك موارد عدة، وعدم التخطيط لهذه الموارد سيؤدي إلى نفادها وعدم استثمارها الاستثمار الأمثل, وكذلك يقدّم لنا التخطيط تنبوءات عن المستقبل، فنشعر بالأمان، ولا نقع فريسة الأوهام.
مبادئ التخطيط
هناك مبادئ عدة للتخطيط: منها مبدأ الواقعية: بمعنى أن تكون الخطة منسجمة مع الواقع،وهنالك مبدأ المرونة أي أن تكون هنالك قابلية لتعديل الخطة لتنسجم مع المتغيرات الحاصلة، وأيضاً مبدأ الشمولية أي ألا يقتصر التخطيط على جانب دون آخر، بل لا بدّ من أن يكون شاملاً لمختلف إشكاليات الشركة المُخطط لها, كما هناك مبدأ التناسق بمعنى أن تكون الخطة منسجمة مع الأهداف والسياسات والظروف.
ومن شروط الخطة الناجحة أن يكون لها هدف واضح ومحدد، وأن تكون بسيطة، سهلة الفهم والتنفيذ، أضف إلى ذلك أنّه لا بدّمن أن تكون واقعية، ومبنية من الأسفل إلى الأعلى ، أي أن يبدأ المُخطط بالخطط الفرعية ليصل إلى الخطة الكلية، أضف إلى ذلك أنه لا بّد من إشراك المشرفين في وضع الخطة ورسم تفاصيلها.
وللتخطيط أنواع فمن حيث الزمن هناك تخطيط طويل المدى، وهو الذي يغطي فترة زمنية طويلة؛ خمس سنوات فما فوق، ومن فوائد هذا التخطيط أنّه يطمح لأهداف كبرى، ويمنح العاملين فرصة كبيرة للتأقلم مع آليات العمل وتوجهاته، وهناك, أيضاً, تخطيط قصير المدى، وهو التخطيط الذي يغطي فترة زمنية أقل من سنة، وهو مرتبط, غالباً, بأهداف صغيرة.ومن حيث الوظيفة فهناك تخطيط الإنتاج: وهو التخطيط الذي يركز على إنتاجية الشركة، وهناك تخطيط التسويق، أي ذلك التخطيط الذي يركز على الترويج للشركة ومنتجاتها، وهناك التخطيط المالي الذي يركز على الجوانب المالية مثل كيفية الحصول على الأموال وآليات استثمارها، وهناك تخطيط القوى العاملة، أي ذلك التخطيط المركز على الجانب البشري، فيهتم بالقوى العاملة واستقطابها وتدريبها، ومن حيث مدى التأثير فيمكننا أن نتحدث عن التخطيط الاستراتيجي: وهو التخطيط الذي يكون مهمّاً، ويُحدث تغييراً كبيراً في المنطقة، وتمارسه إدارة عليا، ويكون تأثيره بالغ المدى، والتخطيط التكتيكي: وهو الذي تمارسه الإدارة الوسطى والعليا، ويكون تأثيره متوسط المدى، ويوضع لمساعدة التخطيط الاستراتيجي.
ومن أبرز ما يعيق التخطيط عدم الدقة في المعلومات والبيانات، والاتجاهات السلبية للعاملين اتجاه الخطة، وإغفال الجانب الإنساني, ما يؤدي إلى مقاومة العاملين للخطة ووضع عراقيل في طريقها، إضافة إلى عدم اتباع الخطوات الدقيقة للخطة.
ويمر التخطيط بمرحل؛ إذ لا بد، في البداية، من دراسة العوامل المحيطة؛ سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية، أضف إلى ذلك أنه لا بدّ من دراسة بنية المنشأة التي يُخطط لها، لنضع، بعد ذلك، أهدافنا وبدائلنا في ضوء هذه السياقات الخارجية والداخلية، وفي هذا السياق لا بد من أن نقارن بين البدائل ونحدد البديل الأفضل والأكفأ، لننتقل إلى مرحلة التنفيذ في ضوء الأهداف والآليات المحددة، وبعدها لا بدّ لنا من المراقبة المستمرة لالتزام فريق العمل بالآليات واتجاههم الصحيح نحو تحقيق الأهداف.
التنظيم الإداري:
إنّ التنظيم هو الترتيب المنظم للمجهودات الجماعية, من أجل الوصول إلى وحدة النشاطات, سعياً إلى تحقيق هدف مشترك، والتنظيم، أيضاً، هو عملية تصميم أساسها تقسيم العمل، وتحديد المسؤوليات، والسلطات، والعلاقات لتحقيق التنسيق اللازم لبلوغ هدف معين.وللتنظيم أهمية بالغة، إذ له دور كبير في توضيح بيئة العمل, وبيان دور كلّ شخص، أضف إلى ذلك أنّ التنظيم يحد من الفوضى وتداخل المهام، ويمنع الازدواجية في الاختصاصات، خالقاً تنسيقاً نموذجياً ضمن المؤسسة.
وللتنظيم أنماط أيضاً، فهناك النمط الكلاسيكي الذي يقوم على تخصص كلّ وحدة إدارية بمهام محددة، وهناك النمط العضوي الذي يقوم على كسر نمط التخصص الدقيق؛ إذ يجوز تجاوز المهام ما دامت في صالح تحقيق الهدف، أما خطوات التنظيم فعديدة وأهمها احترام الخطط والهدف، وعدم تجاوزهما، ومن ثم تحديد الأنشطة الضرورية للوصول إلى الهدف، كما لا بدّ من فحص الأنشطة وتحديد الأكفأ للقيام بها، ليحدث بعد ذلك التفويض بالعمل.
أساليب التنظيم:
هنالك أسلوبان مركزيان للتنظيم؛ الأسلوب المركزي والأسلوب اللامركزي.
الإسلوب المركزي:هو أول النظم التي اتبعتها الدول في الحكم والإدارة، وتقوم المركزية على أساس التوحيد وعدم التجزئة، ويُقصد بها في علم الإدارة توحيد السلطة وجمعها في يد شخص واحد، وتلتزم مختلف العناصر الأخرى بقرارات هذا الشخص المحتكر للسلطة، أما الإسلوب اللامركزي:فيقوم في الأساس على مبدأ توزيع السلطة، إذ لا يمكن لأحد أن يحتكر هذه السلطة أبداً، وقد يوجد، هنا، شخص مركزي، يُظن أنّه في رأس هرم السلطة، لكنه ليس كذلك على الصعيد الفعلي إذ أنّ السلطة مُقسمة.
ومما يعيق التنظيم عدم وجود أهداف أو خطط, والتكاسل والتأجيل, والنسيان, ومقاطعة الآخرين, وعدم إكمال الأعمال أو عدم الاستمرار في التنظيم. ولمعالجة هذه المعوقات لا بدّ من التخلص من كل عمل غير مفيد, والتخطيط الدائم للمستقبل, ومحاولة استشراف الفرص واستغلالها, والمحاورة مع الآخرين في سياق العمل لزيادة كفاءة المؤسسة, بل يجب أن نعيد النظر في التنظيمعند حدوث تغيرات في حجم العمل ونطاق الشركة, أوعند تغير الإدارة وإتيان إدارة أخرى تمتلك أفكاراً جديدة, أوفي حال وجود قصور في العمليات داخل الشركة.
التنسيق الإداري:
يعني تضافر الجهود المشتركة للموظفين، كلّ فيما يخصه، بشكل يكمل بعضه بعضاً، في أداء إداري موحّد من أجل الوصول إلى هدف محدد.وهو, أيضاً, عمل جماعي مشترك، يظهر فيه الموظفون، من رؤساء ومرؤوسين، أثناء أدائهم لأعمالهم كالبنيان المرصوص، وفي انسجام وتفاهم كالجسد الواحد لإنجاز مهمة معينة.والتنسيق هو أحد الأهداف الأولية لكلّ مدير، وبالرغم من ذلك فإنّ المدير القدير لا يخصص إلا جزءاً صغير من وقته للتنسيق، وذلك لأنّه يمكن تحقيق التنسيق من خلال الاستخدام الماهر لكلّ المظاهر الإدارية.
ومن وظائف التنسيق منع الازدواج في الأنشطة الإدارية، ومنع المنافسة الضارة،وتحقيق التوازن والانسجام بين مختلف أوجه النشاط في المؤسسة، كما يؤدي إلى تجنب الصراعات، ويحقق الأهداف بأقل وقت ممكن وأقل جهد. وكلما زاد التداخل بين الأقسام كلّما ازداد التنسيق صعوبة، كما أنّ تعدد الأهداف وتمايزها يجعل التنسيق صعباً. وللتنسيق أنواع فهناك التنسيق الرأسي أي التنسيق الذي يكون بين العناصر الإدارية المركزية، وهناك التنسيق الأفقي وهو التنسيق بين عنصرين في الشركة على نفس المستوى. والتنسيق الخارجي أي التنسيق الذي يكون بين المنظمة والمنظمات الأخرى، والتنسيق الداخلي ألا وهو التنسيق بين جميع العناصر ضمن الشركة الواحدة.
ومن عوامل التنسيق الناجح الإيمان بالهدف, والاقتناع بوجود غرض محدد وراء النشاط الإداري, إضافة إلى القيادة الواعية، فالوعي, واليقظة, والشورى تبني القيادة الفعاّلة التي يمكنها التنسيق والتوفيق بين الأمور, كما لا بدّ من توفر المعلومات، إذ لا يمكن تصور قيام نشاط بشري ناجح ومنسق من دون وجود معلومات يستند إليها, أما ما يعيق التنسيق فهو كبر حجم المؤسسة, وتعقدها, وتنوع أهدافها, وكثرة عدد الأفراد داخلها, ونقص خبرات القائد الإداري, وكثرة المتغيرات الحاصلة.
التوجيه الإداري:
إنّ التوجيه هو وظيفة من وظائف الإدارة، ويعني مجموع الإرشادات, والنصائح, والأوامر, والتعليمات الشفوية والمكتوبة، الصادرة من الرئيس إلى مرؤوسيه، بإسلوب حسن بعيد عن التهجم والتهكم والسخرية.وهو, أيضاً, عملية إدارية تنفيذية تنطوي على قيادة الأفراد, والإشراف عليهم, وتوجيههم وإرشادهم حول كيفية تنفيذ العمل المطلوب.
والتوجيه يقوم على مبدأ تجانس الأهداف أي التوجيه يكون فعّالاً عند تجانس الأهداف الفردية مع الأهداف الجماعية, وكذلك يقوم على مبدأ وحدة الرئاسة إذ يكون للمرؤوس رئيس واحد يتلقى منه التوجيهات, ولكي يكون التوجيه فعّالاً لا بدّ للمدير من أن يعتمد مبدأ التحفيز ويؤكد على تبادل المنافع، وأن يتعرف على حاجات المرؤوس وتوجهاته وأهدافه، أضف إلى ذلك أنه من الضروري الإنصات إلى المرؤوس واعتماد مبدأ الحوار، كما لا بدّ من شرح المهام والتشجيع المستمر,ومن عوامل نجاح التوجيه:عدم جعل التوجيه نزاعاً من أجل السلطة,والابتعاد عن الأساليب الخشنة,وإعطاء الموظف فرصة لطرح الأسئلة,وتجنب أسلوب الأوامر, وعدم تحميل العامل أكثر من طاقته.
والتوجيه, أيضاً, كان موجوداً في حضارتنا العربية الإسلامية؛ إذ تمظهر في: وحدة الأمر أي هناك رئيس واحد لكل مرؤوس، والشورى: أي عملية التوجيه ليست تسلطاً أو تجاهلاً للآخرين, بل لا بدّ من مشاورتهم والاستفادة من آرائهم, كما يتمظهر أيضاً في التضامنية أي القائد مسؤول عما يقوم به المرؤوسون, كما أنّ المرؤوس مسؤول أمام القائد عما قام به من أعمال, ومراعاة الاعتبارات الإنسانية فالتوجيه في الإدارة الإسلامية قائم على الرحمة والتعاطف لا الجبروت والتسلط.
ويقوم التوجيه على أسس ثلاثة:
الاتصال:
إنّ الاتصال يعني تدفق التوجيهات, والملاحظات, والأوامر من جهة إلى جهة أخرى، وذلك بقصد اتخاذ قرار محدد وتنفيذه,والاتصال وسيلة وليس غاية، وفي عملية الاتصال الإداري كلّ فرد هو مرسل ومستقبل في آن معاً.وللاتصال عناصر؛ المرسل: أي الذي يقوم بالاتصال ويرغب بتوصيل رسالة إلى الآخر, والمُستقبِل: هو الذي يتلقى الاتصال ورسالته, والرسالة: هي موضوع الاتصال وقد تكون طلباً أو رجاءً أو نصيحةً. أما الوسيلة فهي الطريقة التي يحدث فيها الاتصال، وكذلك هناك مكان الاتصال وزمانه, إضافة إلى التغذية الراجعة؛ أي ردة الفعل التي تحدث نتيجة استقبال المستقبِل للرسالة. فعملية الاتصال لا تنتهي بانتهاء إرسال الرسالة.ومن أبرز معوقات الاتصال اللغة، وتباين الخصائص بين المرسل والمستقبِل,ونقص الاستعداد لنفسي للمستقبِل,ولتحقيق اتصال ناجحلا بد من إزالة العقبات النفسية,وتوجيه الرسالة على مراحل,والعمل على وضوح الرسالة ودقتها,والمتابعة عن طريق التغذية الراجعة.وللاتصال دور في جميع العمليات الإدارية من تنظيم, وتخطيط, ورقابة, وتنسيق, واتخاذ قرار ولا عجب أنّ أغلب المشكلات الإدارية تعود إلى سوء الاتصال.
القيادة:
هي عملية التأثير في نشاطات ووظائف مجموعة الأعضاء, وتوجيهها إلى اتجاهات محددة, وتقوم القيادة على عناصر, وهي: وجود القائد, والأفراد التابعين, والأهداف. وللقيادة مداخل: فهناك المدخل الفردي أي لا بدّ من وجود خصائص محددة لدى القائد، وهذه الخصائص فطرية.المدخل السلوكي وهو الذي يرى أنّ خصائص القيادة قد تُتعلم, ولا دور للفطرة فيها. والمدخل الموقفي ويذهب إلى أنّ الظروف والسياقات التي يوضع فيها الأشخاص هي التي تجعلهم قادة.وللقيادة نوعان قيادة مباشرة وتعتمد على الاتصال الشخصي مع القائد, وقيادة غير مباشرة يؤثر فيها القائد من خلال أعماله ومؤلفاته بالآخرين دون أن يتصل بهم اتصالاً مباشراً.
الحوافز والروح المعنوية:
تتضمن عملية التوجيه بث روح إيجابية بين العاملين، وتنمية روح التعاون، والتحفيز على الإنتاجية، ويكون التحفيز من خلال إشعار العاملين بأهميتهم، واستخدام التوجيه لا الأمر، ومنح الأجر العادل، وتوفير برامج الخدمات والمزايا الإضافية، وتوفير الاستقرار للعاملين.
عملية اتخاذ القرارات:
إن الهدف الأساسي التي تهدف أي شركة لتحقيقه من خلال العمليات الإدارية المختلفة هو الوصول إلى اتخاذ قرار مناسب لتطوير الشركة أو حل المشكلات, وتتخذ هذه العملية عدّة مراحل: أبرزها العصف الذهني والذي تُطرح فيه مقترحات عشوائية دون مناقشتها, وبعد انتهاء هذه العملية يبدأ المجتمعون بتحليل تلك المقترحات وتوضيح نقاط قوتها وضعفها، ليتوصلوا إلى الاقتراح الأنسب الذي يمكن للشركة أن تتخذه.وعملية اتخاذ القرارات عملية مهمة تقوم على اصطفاء الخيار المناسب، ومفتاح النجاح هو اتخاذ القرارات السليمة.
ويتضمن أي قرار ثلاثة عناصر؛ الاختيار: عملية القرار قائمة في جوهرها على الاختيار, وقد يتوفر لصاحب القرار حرية كبرى في الاختيار وقد تكون حريته محدودة, وحتى عندما تتوفر لصاحب القرار حرية كبرى في الاختيار فإنّ هذه الحرية تبقى محدودة في المعطيات السياقية, فكلّ عملية اختيار هي عملية متأثرة بضغوط الموقف, البدائل: إنّ أي مشكلة لها أكثر من حل، أي هناك بدائل كثيرة، ويجب هنا مقارنة هذه البدائل وترتيبها واختيار البديل الأنسب, الأهداف: فلا نتخذ قراراً إلا إذا كان لدينا هدف من وراء هذا القرار, وكلما كان الهدف أكبر كلما صعب اتخاذ القرار.
ومن العوامل التي تؤثر في اتخاذ القرار؛أهداف الشركة: إذ لا شك أنّأي قرار يؤخذ يجب أن يكون مناسباً لتحقيق أهداف الشركة, كما تؤثر الثقافة السائدة في المجتمع بالقرار: أي لا بدّ من الاهتمام بنسق القيم الحاضر في المجتمع، والعمل على أن يكون القرار منسجماً معه, ومن هذه العوامل, أيضاً, الوقائع: أي لا بد من أن تتخذ الوقائع بعين الاعتبار عند اتخاذ أي قرار, كذلك مما يؤثر في اتخاذ القرار هو شخصية متخذ القرارات, وقيمه, وسلوكياته, وميوله, وحالته النفسية.وللقرار أنواع فهناك قرارات شخصية وقرارات عمومية خارج ذاتية، وهناك قرارات روتينية نتخذها كلّ يوم, وهناك قرارات كبرى لا نتخذها إلا في مراحل محددة من تطور حياتنا ومسؤولياتنا, ويوجد, أيضاً, قرارات تُتخذ وتنفذ مباشرة وبسرعة, وقرارات تُنفذ بعد فترة, وأحياناً هنا كقرارات ينفذها الشخص الذي اتخذ القرار, وقرارات ينفذها شخص آخر, وهناك قرارات يتخذها شخص وينفذها مجموعة اشخاص, وهناك قرارات تتخذها الجماعة وتنفذها. وتأكد أن لا مجاملات في اتخاذ القرار, كما لا مكان للعواطف, واحذر أن تتردد أو تتراجع واعمل على عدم إذاعة القرار المتخذ إلى أن تنفذه وترى نتائجه.
الرقابة الإدارية:
تنطوي الرقابة على مجمل الأنشطة والأعمال التي تُصمم كي تجعل الأحداث متماشية مع الخطط الموضوعة، إذ تقوم على التحقق من أنّ كل شيء يحدث طبقاً للخطة الموضوعة, وتكمن أهمية الرقابة في أنها تمنع حدوث الأخطاء, وتتأكد من حسن سير العمل, كما تشجع على النجاح الإداري.أما أهداف الرقابة فهي حماية الصالح العام, وتوجيه القيادة, أحياناً, إلى ضرورة التدخل السريع, كما من وظائفها كشف الانحراف وتقليل الأخطاء.ولا بدد للقيادة من عناصر مثل وجود جهاز إداري جيد، وموظفين أصحاب خبرة، ووجود آليات ووسائل فعّالة للمراقبة, مثل: الموازنة التقديرية, والبيانات, والإحصاءات, والملاحظة الشخصية, وتمر الرقابة بمراحل؛ إذ لا بدّ, أولاً, من تحديد المعايير, والمعيار هو رقم أو مستوى محدد من الجودة, ليُنتقل, بعد ذلك, إلى قياس الأداء باستخدام أدوات الرقابة, لتأتي في النهاية مرحلة المقارنة بين البيانات والأهداف الموضوعة, وفي حين كان هنالك تقصير أو خلل يجب معرفة السبب ووضع الحلول المُعالجة, إلا أن هذه الرقابة تفشل إذا كانت رقابة زائدة ومبالغ فيها وتركز على الامور الهامشية .
المسؤولية الاجتماعية وأخلاق المهنة:
إنّ المسؤولية الاجتماعية هي تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء المجتمع، وهي, أيضاً, التزام الشركات بالتصرف أخلاقياً, والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين الظروف, أما أخلاقيات العمل فهي مجموعة من المبادئ والمعايير التي تحكم سلوك الافراد والجماعات, وتساعد في تحديد الخطأ من الصواب, ومن ثم تحديد الكيفية التي تُنجز من خلالها الأشياء, وفي بدايات هذا القرن تغيرت الظروف وتبدلت فأُصدرت قوانين جديدة لمواجهة الأنشطة الخادعة, ويبدو أنّالاهتمام بقضايا المسؤولية الاجتماعية تجعل الإدارة أكثر تحسناً, كما تساعد في تهذيب فريق العمل, وتُعد ضمانة على أنّ سياسات الشركة هي سياسات أخلاقية.
خاتمة: إنّ ما تتصف به طبيعة الحياة من صيرورة مستمرة, أوجب علينا أن نبقى متحفزين وجاهزين لإدراة أي تفصيل صغير في حياتنا, فالإدارة لم تكن, يوماً, خاصة بالمؤسسات والشركات, أو الدول والحكومات, بل هي نشاط إنساني, متأصل في أعماق ذواتنا, ويحسنا دائماً على إخراج مختلف نشاطاتنا بصورة مثلى.