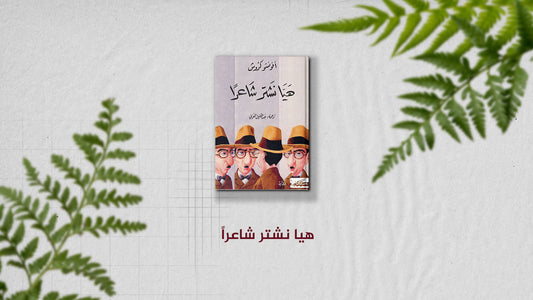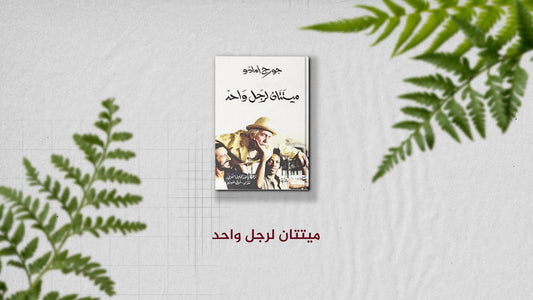مقدمة:مرّت البشرية بمراحل متمايزة من التنظيم الاقتصادي، إذ فرضت كلّ مرحلة تاريخية تنظيمها الاقتصادي الخاص بها، والمنسجم مع سياقاتها العمومية، والممايز لها من المراحل الأخرى ذات التنظيمات الاقتصادية المختلفة، ولأنّ هذه النظم الاقتصادية لها دور هائل في التعبير عن خصوصية المرحلة، ولأنّ هذه النظم، أيضاً، مؤثرة في حياة الشعوب، وسلوكياتها، وتفاعلاتها كان لا بدّ لنا من الاهتمام بها، ومناقشتها مناقشة علمية جادة، ومن الكتب المعتنية بهذا المجال, تحديداً, كتاب: "النظم الاقتصادية المعاصرة"لمؤلفه "محمد يونس عبد الحليم"، والذي سنتوقف عنده، في وريقاتنا الآتية, محاولين استعراض آرائه، وأفكاره، ومناقشاته.
الاقتصاد في المرحلة البدائية:
إنّ الحياة التي نحياها، بما فيها من رفاهية ورخاء، هي حياة غير مماثلة للحياة في العصور السحيقة، إذ كان الإنسان في العصور القديمة يسكن الكهوف، ويتغدى على الصيد وثمار الأشجار، مستخدماً أدوات بدائية تساعده في قضاء شتى حاجاته.
غير أنّ هذه الحالة لم يكن من الممكن أن تستمر، إذ اكتشف الإنسان الزراعة، ودجّن الحيوانات، وتفاعل مع أخيه الإنسان، وكوّن جماعات كبيرة بعض الشيء، واتجه إلى تقسيم العمل، فعمل البعض بالزراعة، كما عمل البعض الآخر في صناعة الأدوات اللازمة لاستمرار الحياة.
وإذا أردنا أن نصف الحياة الاقتصادية في هذه المرحلة من تاريخ البشرية فسنقول: إنّها حياة اقتصادية بسيطة؛ فالأدوات محدودة, وذات طابع شخصي في الغالب، أما الإنتاجية فهي مخصصة لتلبية الاحتياجات غير بعيدة المدى، إذ ينتج الإنسان ما يحتاجه فقط، دون أن يكون هنالك أي فائض.
نظام الرق:
تطورت أدوات الإنتاج، فزرع الإنسان محاصيل متنوعة وكثيرة، وغدا لديه فائضاً من الموارد، أي أضحت الحياة الاقتصادية بمجملها أكثر تقدّماً، زد على ذلك أنّ هذه الحياة الاقتصادية الجديدة فرضت تقسيماً اجتماعياً محدداً، فغدا لدينا طبقتين اجتماعيتين، طبقة الأحرار، وطبقة العبيد، ولم يكن توزيع الإنتاج عادلاً بينهما، بل إنّ ما ينتجه الرق يذهب بالكامل إلى السيد، فلا يبقى لديه ما يسدّ حاجاته الأساسية، وهذا الحالة المزرية وغير الإنسانية أفضت إلى العديد من ثورات العبيد، الرافضين سياقاتهم القائم، والمتطلعين إلى سياقات أكثر عدلاً وحريّة.
النظام الإقطاعي:
ساد هذا النظام، تحديداً، في العصور الوسطى من تاريخ البشرية، ويقوم، في أساسه، على إقطاعات صغيرة، كلّ إقطاع منها يعادل حجم قرية، وأراضي هذه الإقطاعية تكون موزعة بين السيد والعبد، ومهمة زراعة الأرض كانت موكلة للعبيد، الذين كانوا يدفعون جزية محددة لسيدهم، في حين أنّ السيد كانت مهمته حماية أمن الإقطاعية، والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي، بالإضافة إلى منح العبيد المال اللازم للزراعة.
وكان لا بدّ لهذا النظام من أن يتلاشى، ومن أهم أسباب تلاشيه: زيادة عدد السكان، وحدوث الثورة الصناعية التي أدت إلى تهميش العمل الزراعي السائد في المرحلة الإقطاعية، وتبلور فكرة الملكية الخاصة، وقيام ثورات تحررية عدّة تهدف إلى القضاء على نفوذ طبقة السادة، بالإضافة إلى كتابات المفكرين والفلاسفة المتمحورة حول المساواة والحرية.
النظام الرأسمالي:
لا بدّ لنا, في البداية, من أن نتحدث عن العوامل التي أدت إلى نشوء النظام الرأسمالي، ولعلّ أهمها: استتباب الأمن، ونشوء الطرق، مما طور الحركة التجارية ودفعها إلى الأمام، والكشوفات الجغرافية التي خلقت مجالات جديدة للتجارة والاستثمار، زد على ذلك الثورة الصناعية, وتطور وسائل الإنتاج.
أما أبرز خصائص الرأسمالية فهي: السعي للحصول على أكبر ربح ممكن، فالمقولة المركزية للرأسمالية هي الأرباح الهائلة، وتهميش الروح الفردية في الإنتاج، والتي كانت حاضرة عبر العصور السابقة، والحرية في العمل والتبادل من دون وجود ضغط من السلطات.
وتذكر، دائماً، أنّ لكلّ مرحلة تاريخية نظامها الرأسمالي الخاص، فعلى سبيل المثال: تميزت رأسمالية القرنين السابع عشر والثامن عشر بكثرة وحدات الإنتاج، وعلى الرّغم من كثرتها إلا أنّه لم يكن بمقدورها السيطرة على السوق وإخضاعه، بل إنّها كانت الخاضعة له ولمتطلباته، أما رأسمالية القرنين التاسع عشر والعشرين فغدت هي المسيطرة على السوق، والقادرة على فرض خياراتها, بل تذكر، أيضاً، أنّ الرأسمالية تختلف في درجاتها؛ فالرأسمالية الأمريكية، مثلاً، متقدمة على الرأسمالية الفرنسية، أما رأسمالية العالم الثالث فهي رأسمالية متواضعة.
تأثير الرأسمالية في الحياة الاجتماعية:
انعكست الرأسمالية في بنية الحياة الاجتماعية، وقد تمظهرت هذه الانعكاسات من خلال:
تقسيم المجتمع إلى طبقتين: الطبقة المالكة، والطبقة العاملة، فالطبقة المالكة هي ممتلكة رأس المال، إذ تتركز الأموال في يدها، ونسبة تعداد أفراد هذه الطبقة قليلة، لذلك تحتاج إلى الطبقة الأخرى ذات التعداد الكبير، ألا وهي الطبقة العاملة، تلك الطبقة المجردة من كلّ شي باستثناء قوة العمل.
ويؤدي هذا التفاعل بين الطبقتين إلى صراع طبقي للحصول على ناتج العمل، بل إنّ هذا الصراع هو الذي يمنح للرأسمالية حيويتها، وقدرتها على التحول المستمر.
وقد انتُقدت الرأسمالية, ومن من أبرز الانتقادات الموجهة لها:
سوء توزيع الدخل والملكية؛إذ يحصل الرأسمالي على الارباح المتراكمة، بينما يحصل العامل على أجرة محدودة، مما قد يؤدي إلى حدوث حقد بين الطبقتين.
الاحتكار؛إذ قد يحتكر بعض الرأسماليين سلعاً محددة، من خلال تحديد حجم الإنتاج، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان السوق منها, وارتفاع أسعارها.
مغالطة التغني المزعوم بالحريات؛تتغنى الرأسمالية بقيمة الحرية، لكن لو تمعّنا بهذه القيمة, وفق منظومتها, سنجد أنّها قيمة مرتبطة بالأغنياء فقط، بل إنّ الفقير في المجتمع الرأسمالي لا يمتلك حرية الاختيار بين السلع، بل تُفرض عليه السلعة المتناسبة مع دخله.
ارتباطها بالاستعمار؛ فقد اتجهت الدول الأوروبية الاستعمارية نحو الدول الإفريقية للسيطرة على مواردها، وجعلها مجالاً لتصريف فائض إنتاجها الرأسمالي، بل إنّ هذه السياسة الاستعمارية أثرت في تراجع اقتصاد الدول المستعمرَة وتأخر تقدمها الصناعي.
النظام الاشتراكي الديمقراطي الحر:
إنّ مصطلح الاشتراكية من المصطلحات المستخدمة بكثرة في سياقاتنا، ومما يجب أن نثير الانتباه إليه أنّ للاشتراكية أنواعاً، ومن أنواعها الاشتراكية الديمقراطية، وتُعرّف بأنّها: نظام آمن به العديد من دول العالم وطبقوه، ويقوم، في جوهره، على إشراك المجتمع في ملكية أدوات الإنتاج، زد على ذلك توزيع فائض الإنتاج على أفراد المجتمع دون تمييز.
ومن أهم مميزات الاشتركية:
_ يساوي النظام الاشتراكي الديمقراطي بين المواطنين في الحقوق، ويعمل على رفع مستوى معيشتهم من دون تمييز بينهم.
_ ينتج النظام الاقتصادي الاجتماعي السلع بما يتوافق مع الحاجات.
_ العامل في النظام الاقتصادي الاشتراكي ذو مكانة اجتماعية مرموقة.
_ الأرباح في الدولة الاشتراكية لا تتراكم في يد فئة محددة.
_ ملكية وسائل الإنتاج ملكية جماعية.
_ المراعاة الحقيقية لمتطلبات العدالة الاجتماعية.
النظام الاقتصادي المختلط:
هنالك خط واضح يفصل بين النُظم الاقتصادية، وهذا الخط يجعلنا نصف هذه الدولة أو تلك بأنّها ضمن النظام الرأسمالي، مثلاً، أو الاشتراكي، بيد أنّ التطورات الاقتصادية المعاصرة جعلت بعض الدول تجمع في نظامها الاقتصادي بين خصائص نظامين اقتصاديين متمايزين تمايزاً مطلقاً، مثل النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، إذ تلتزم الدولة بتحقيق مستوى دخل محدد لمعظم أفراد المجتمع، وذلك دون أن تفرض مستوى الدخل هذا على الأغنياء، فهؤلاء يستطيعون أن يعيشوا في أعلى مستوى اقتصادي, وبحرية تامة, ويكفيهم أن يدفعوا الضرائب المفروضة عليهم.
وتهدف الدولة من وراء هذا الخلط إلى تحقيق الاستقرار النقدي، والحد من البطالة والتضخم، وبلورة معدل معقول من النمو الاقتصادي,والتوظيف الكامل لكافة أفراد الشعب, والمحافظة على استقرار الأسعار, ورفع مستوى المعيشة, وتحقيق النمو الاقتصادي وحصول زيادة حقيقية فيما يحصل عليه الفرد من خدمات وسلع.
النظام الاقتصادي المختلط والتأميم:
يعتبر النظام المختلط التأميمَ، الذي هو عنصر من عناصر النظام الاشتراكي، شراً لا بدّ منه، وهو يلجأ إليه عند الضرورة، فينحرف انحرافاً بسيطا عن الرأسمالية، إذ أن قليلاً من الأشتراكية لا يضر، بل هو مفيد جداً للسياق العمومي، ومن فؤاد هذا التأميم: كسر حدة النظام الرأسمالي البحت، والحد من انتشار البطالة الناتجة عن توظيف الرأسماليين القليل من اليد العاملة، أضف إلى ذلك منع الرأسمالية من وضع يدها على المشاريع القومية في الدولة.
النظام الاقتصادي الإسلامي:
نقصده به الطريقة الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية، بل هو, أيضاً, مجموعة الأصول الاقتصادية العامة, التي نستخرجها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ويمكن أنّ نعرّفه كذلك بأنّه: مجموعة التطبيقات والحلول الاقتصادية النابعة من أسس العقيدة الإسلامية.
ويبدو أن ربط النظام الاقتصادي الإسلامي بالمبادئ الإسلامية لا يحدّ من الاجتهاد, كما لا يؤدي إلى الجمود أيضاً، وذلك لأنّ هذه المبادئ الإسلامية الاقتصادية قليلة جداً, ولا تتعلق إلا بالحاجات الإنسانية الأساسية، فالمجال مفتوح, دائماً, للإبداعية في ضوء هذه المبادئ.
خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي:
من أبرز خصائص هذا النظام:
الشمولية؛ فهو جزء من نظام شامل، وبالتالي لا يجوز دراسة النظام الاقتصادي الإسلامي بمعزل عن عقيدة الإسلام بكلّيتها وشمولها.
التعبدية؛ إنّ النشاط الاقتصادي في الإسلام ذو طابع تعبدي، أي كلّ ما يعمله الإنسان هو جزء من عبادة يُثاب عليها.
السمو؛ فللنظام الاقتصادي الإسلامي هدف سام, فهو لا يهدف فقط إلى النفع المادي المباشر، بل يهدف إلى مستوى أسمى، ألا وهو إعمار الأرض.
الرقابة الذاتية؛ فهذا النظام لا يقوم على الرقابة السلطوية المباشرة فحسب، بل يعتمد بشكل كبير على رقابة ضمير الفرد المؤمن بالله واليوم الآخر.
التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة؛ فالنظام الاقتصادي الإسلامي لا يركز على الفرد فحسب كما يفعل النظام الرأسمالي، ولا يركز كذلك على المجتمع كما يفعل النظام الاشتراكي، بل يعمل على رعاية المصلحتين معاً، والتوفيق بينهما.
الملكية المزدوجة في الاقتصاد الإسلامي:
يعطي النظام الاقتصادي الإسلامي الحقّ للفرد بالتملّك، دون أن يفرض عليه أية قيود، أضف إلى ذلك أنّ هذا النظام لا يمنع الملكية العمومية أيضاً، ولا سيما لمرافق الدولة الأساسية.
ويرى النظام الإسلامي أنّ الملكية في جوهرها لله تعالى، والإنسان هو خليفة الله في الأرض، ووظيفته العمل في ملك الله لخيره ولخير المجتمع أيضاً.
وكذلك حمى الإسلام الملكيات الفردية ونهى عن الاعتداء عليها، فحرم أكل مال اليتم، والسرقة، ووضع طرقاً محددة لاكتساب الملكية, ألا وهي: الزراعة, والعمل, والعقود الناقلة للملكية, والميراث, وما إلى ذلك من طرق, أما الملكية العامة فتشمل: أرض الحمى؛ أي الأرض التي يقوم مالكها بتخصيص جزء منها لانتفاع المسلمين, وكذلك الأراضي الزراعية المفتوحة,والثروات الباطنية.
تقييد الحرية الاقتصادية في النظام الاقتصادي الإسلامي:
والحرية الاقتصادية في الإسلام مقيدة بشروط عدّة, فيجب ألا يكون النشاط الاقتصادي مخالفاً للشرع, كما لا يمكن أن يكون نشاطاً تربوياً, أضف إلى ذلك أنّ الإسلام حرّم المتاجرة بالخمور والغرر؛ أي كلّ ما ثبت ضرره, زد على ذلك أنّه حرّم استخدام النفوذ للحصول على المال, وحرّم, أيضاً, الإسراف, والترف, والاكتناز.
تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي:
تتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لأهداف, ألا وهي: بيع السلع المحتكرة جبراً, تحديد الأسعار منعاً من استغلال الناس, تحويل الملكية الخاصة إلى ملكية عامة لمنفعة العباد.
وهنالك نقطة محددة تميز النظام الاقتصادي الإسلامي من مختلف النُظم الاقتصادية الأخرى, ألا وهي: التكافل الاجتماعي, المتحققة من خلال أداء فريضة الزكاة, فهذه النقطة لها دور مهمّ في تحقيق المساواة الاقتصادية بين مختلف عناصر المجتمع, وذلك بناء على سلوكياتهم الشخصية, والتزاماتهم الدينيّة.
النظام الاقتصادي العالمي الجديد والعالم العربي:
شهد العام 1994 م قيام النظام الاقتصادي العالمي الجديد أو ما يُعرف بالنظام التجاري متعدد الأطراف، ويقوم هذا النظام على:
_ استخدام القواعد متعددة الأطراف، فلا تضع أي دولة قواعدها الاقتصادية بمعزل عن الدول الأخرى.
_ التأكيد على الحماية، إذ قد تحتاج بعض الدول إلى حماية منتجاتها من السلع التنافسية لفترة محددة.
_ عدم التمييز بين الشركاء التجاريين.
_ تأكيد حق الدول النامية في النهوض، وضرورة معاملتها معاملة خاصة.
وقد سعت الدول العربية لإقامة تكتل اقتصادي يهدف إلى التنسيق بين الدول العربية لمواجهة التكتلات العالمية والنهوض بالواقع الاقتصادي للمنطقة, بل من مظاهر تبلور هذا التكتل:اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية عام 1957م, والتي ركزت على حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال, وكذلك السوق العربية المشتركة التي أنشئت عام 1964م.
وفي هذا السياق لا بد لنا من توصيات, ألا وهي: التعجيل بتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة, والتعجيل, أيضاً, بإتمام تنفيذ مراحل السوق العربية المشتركة, إضافة إلى زيادة حجم التجارة البينية العربية, وتفعيل الاتحادات والشراكات,وإعداد برنامج واسع النطاق للتنمية البشرية.
خاتمة:وبالتالي، منذ أن واجه الإنسان المشكلة الاقتصادية وهو دائم البحث عن أسلوب أو طريقة لاستخدام موارده المحدودة في إشباع حاجاته المتعددة، فأوجد أنظمة اقتصادية مختلفة، وعلى الرّغم من أهمية هذه الأنظمة إلا أنّه لا بدّ لنا, دائماً, من مناقشتها ونقدها للوصل إلى النظام الأمثل والمتوافق مع حاجاتنا وطبيعة حياتنا.
كتابة: نور عباس